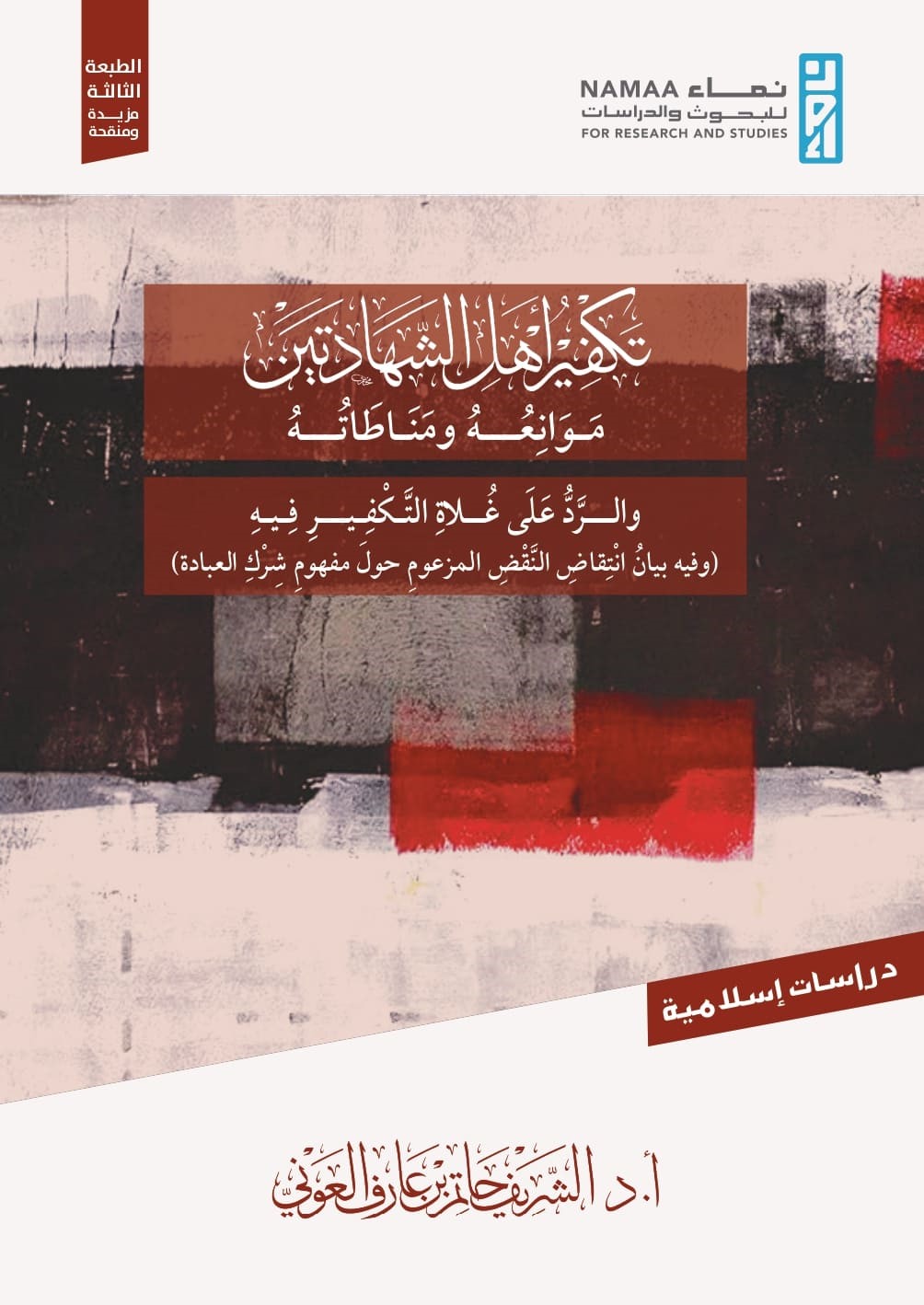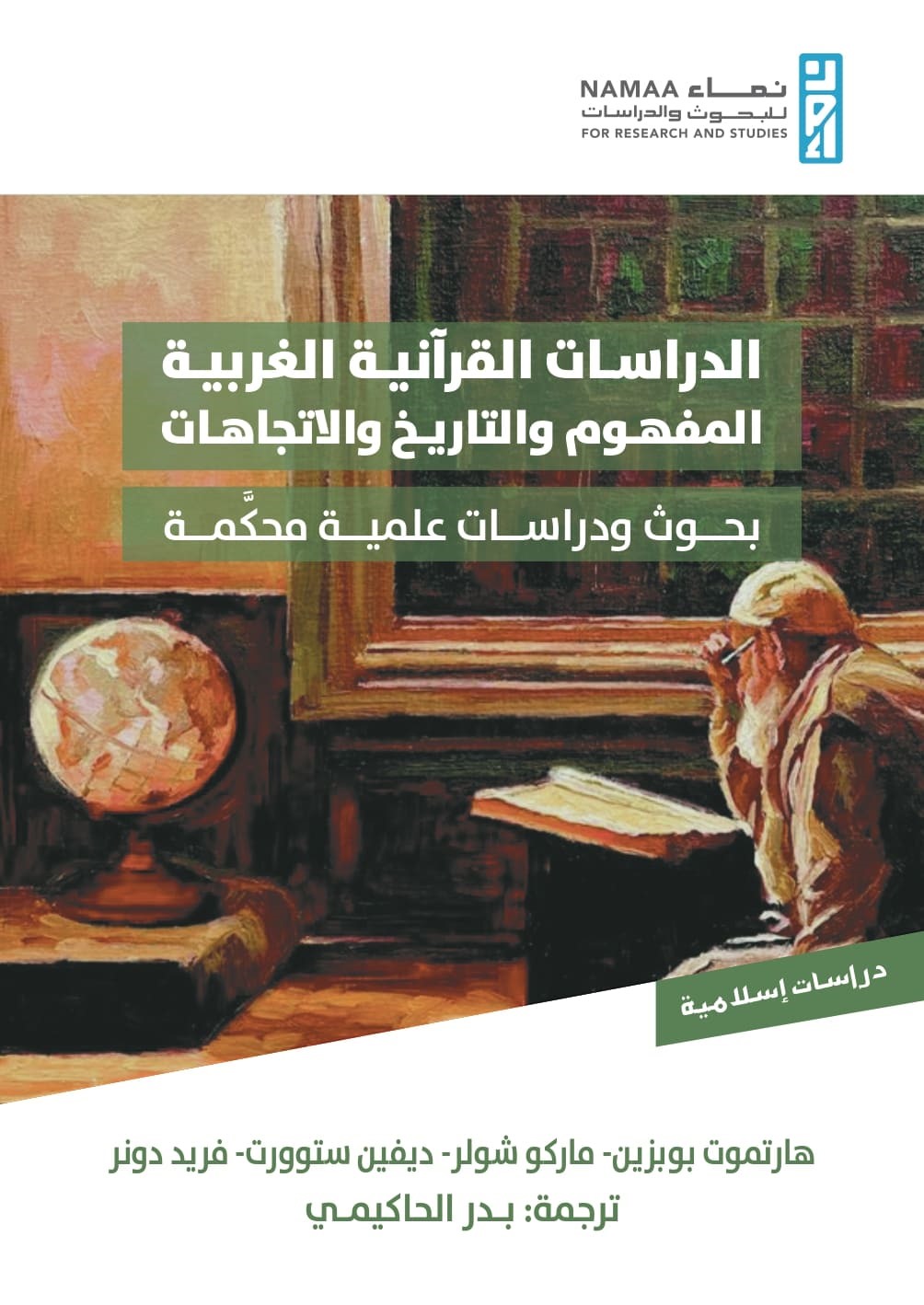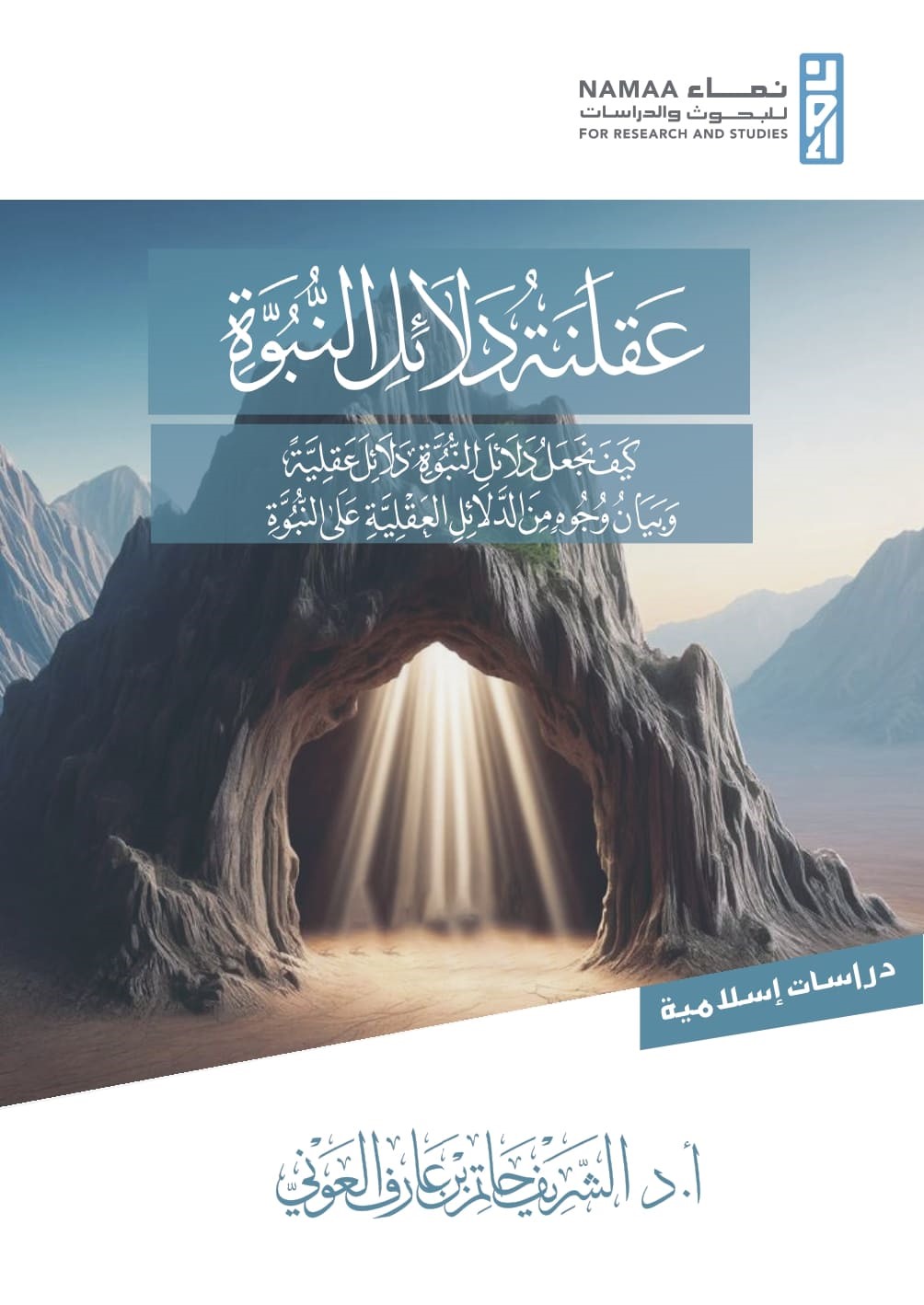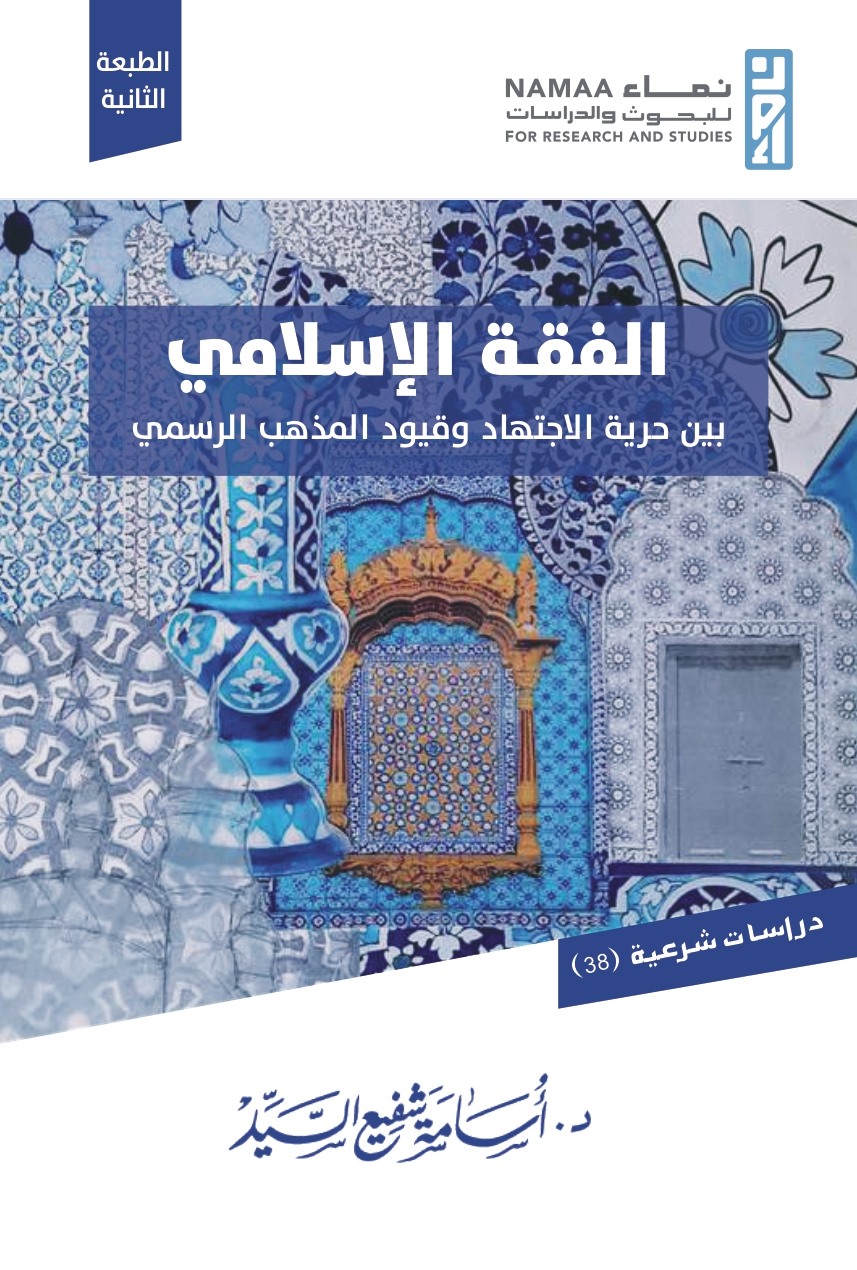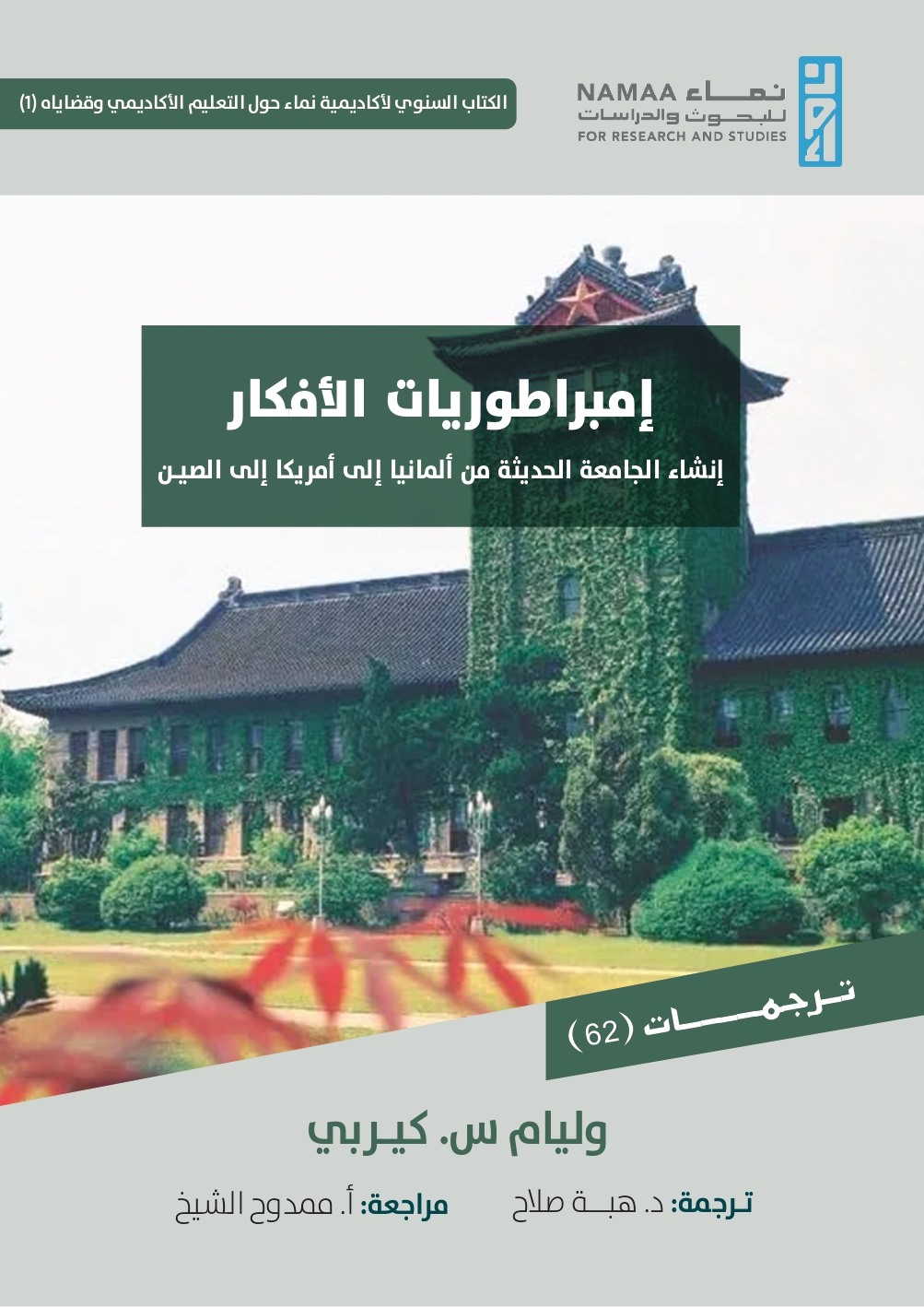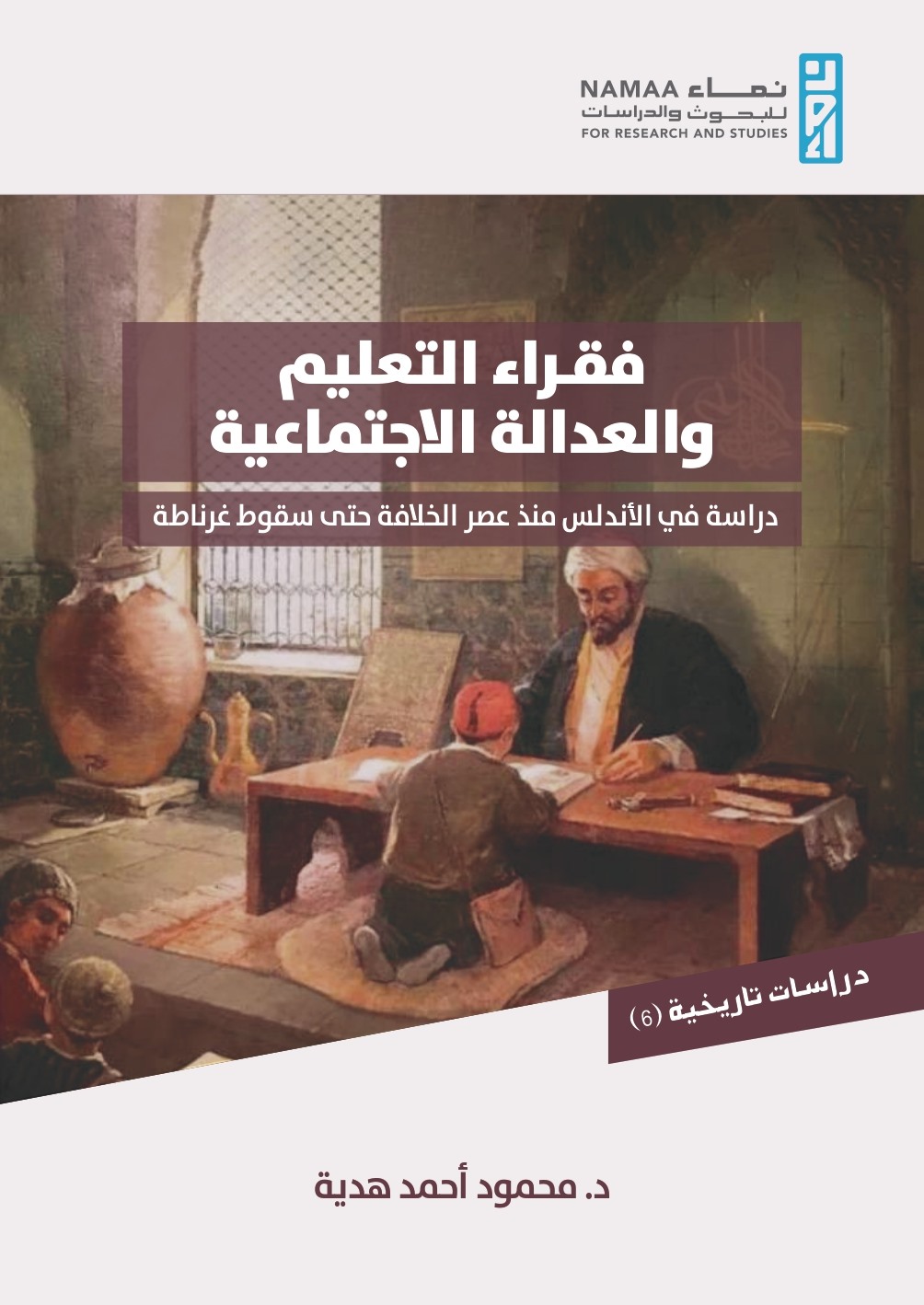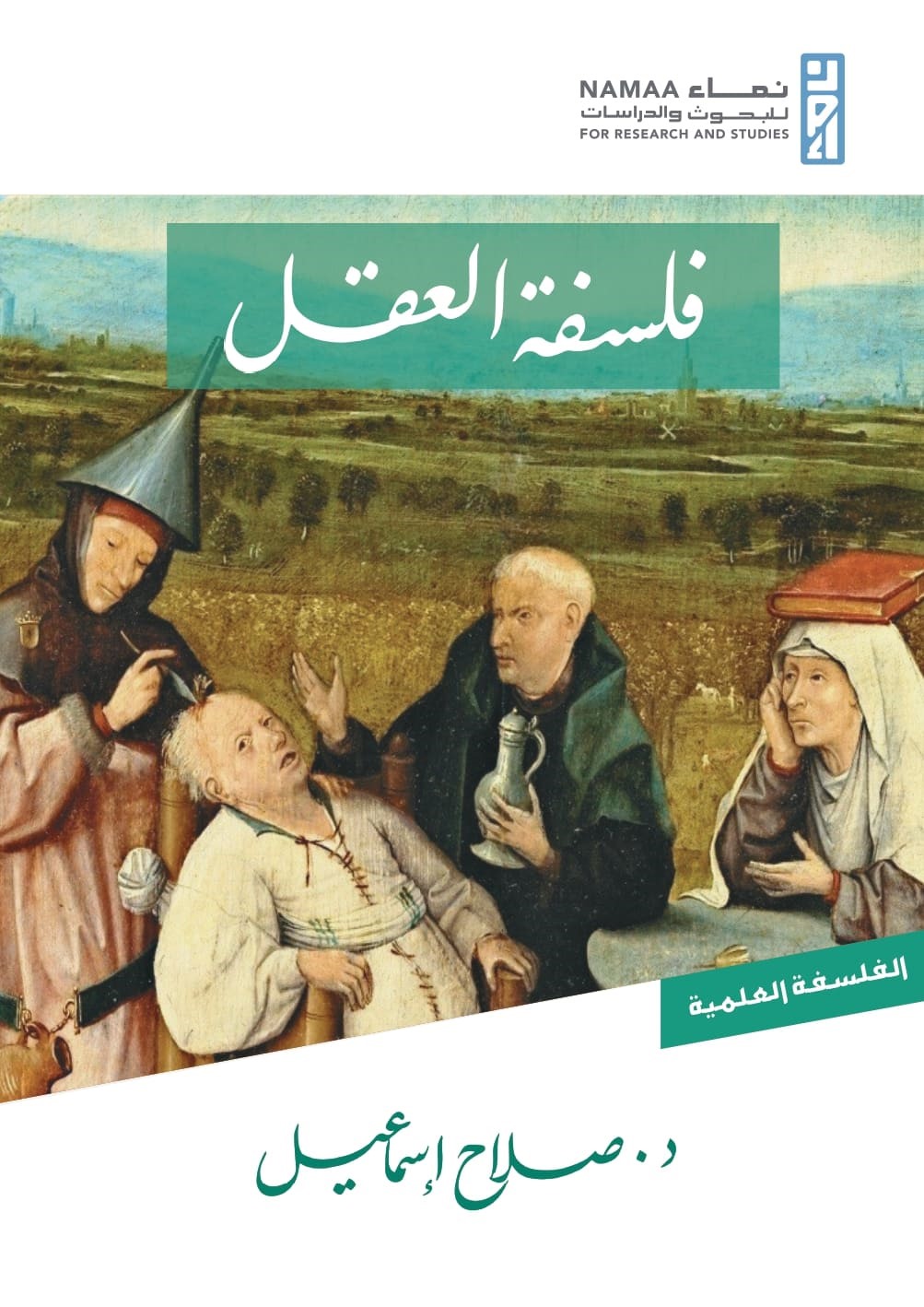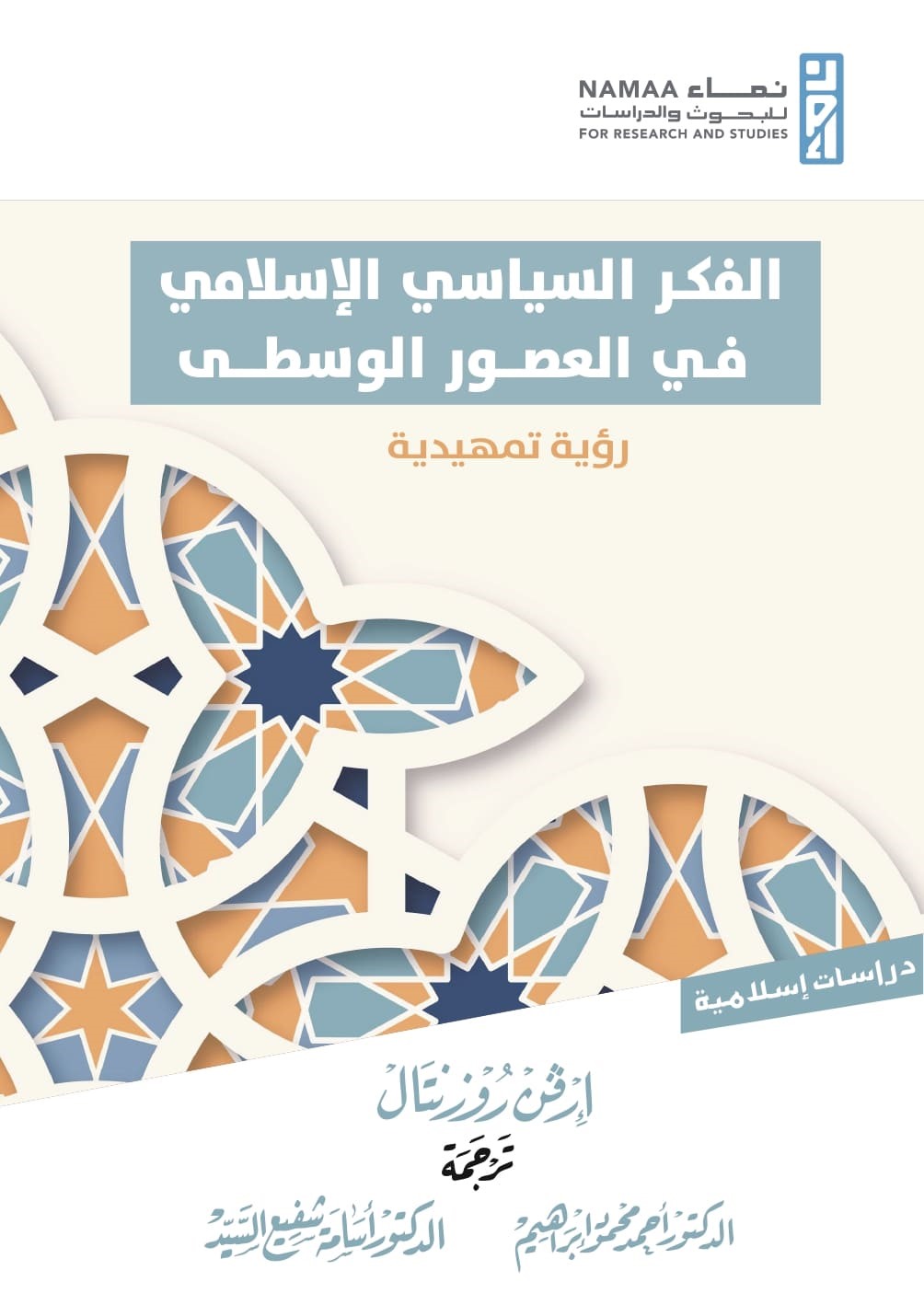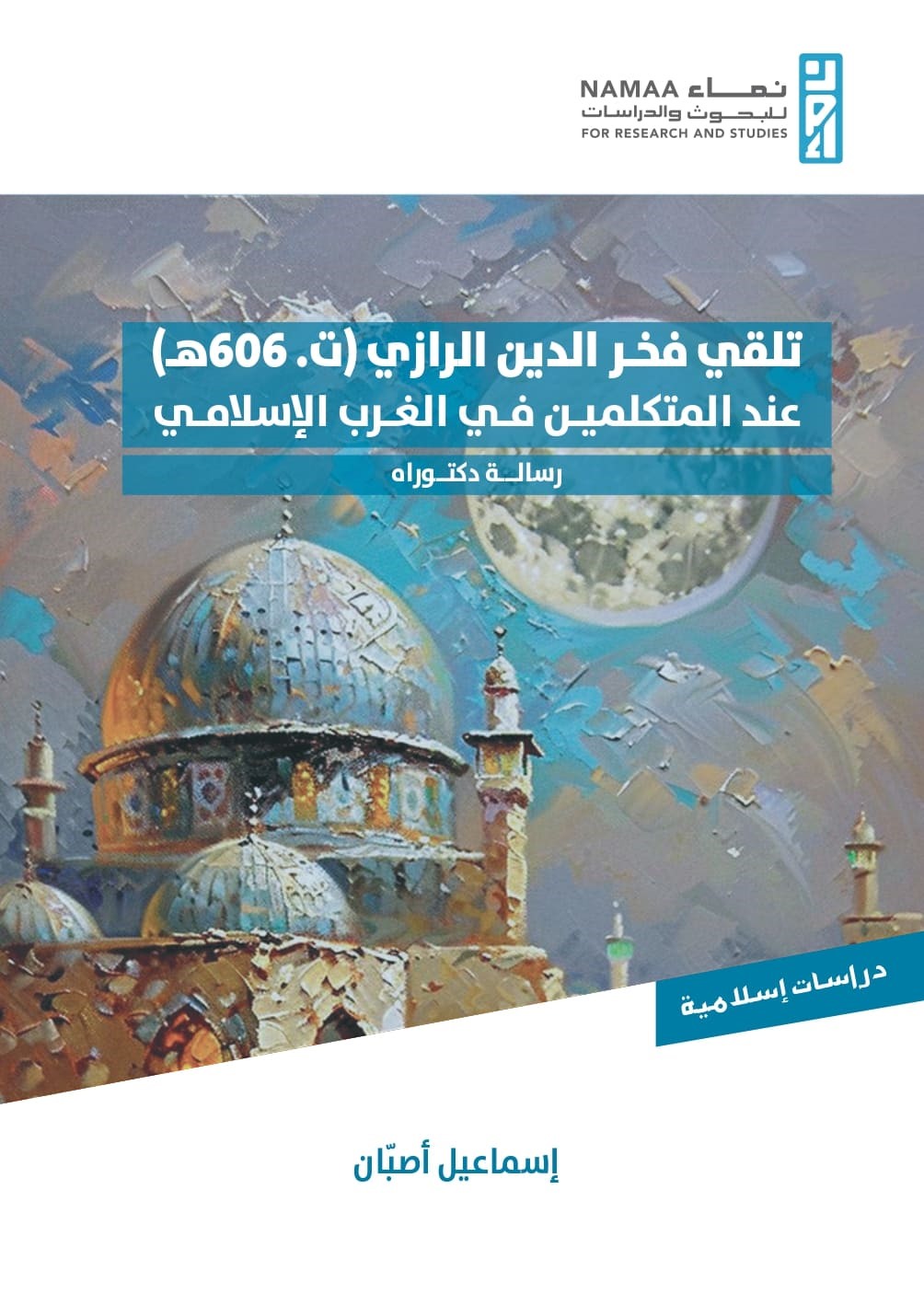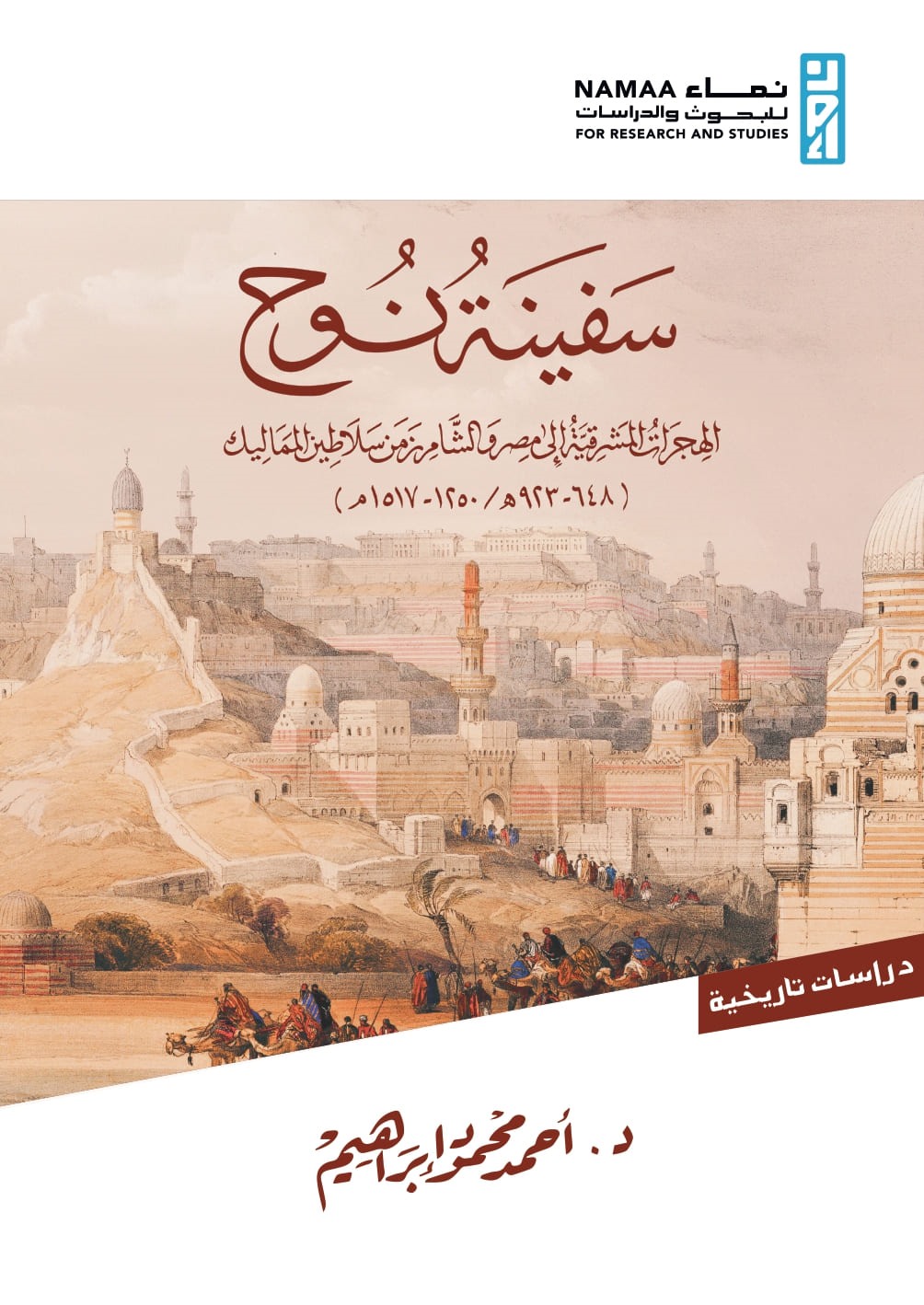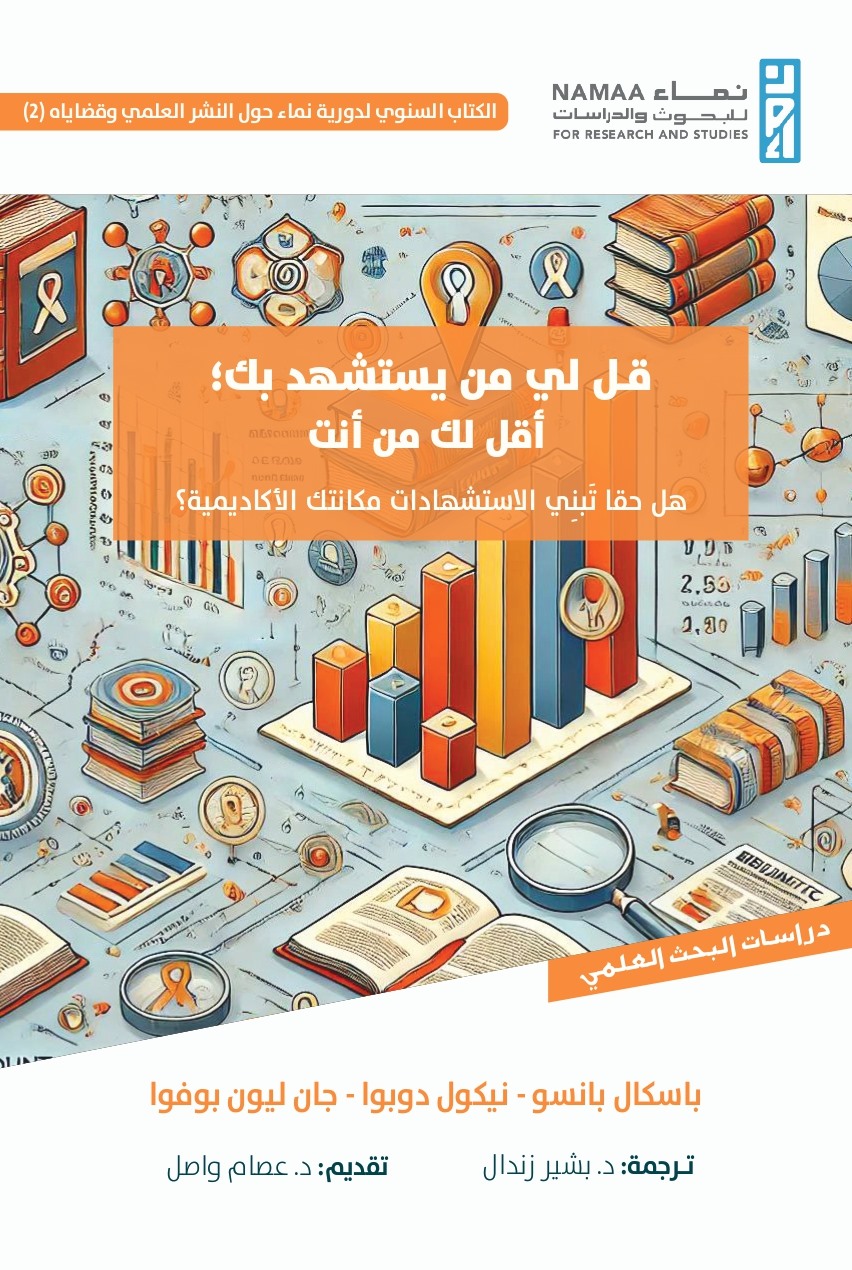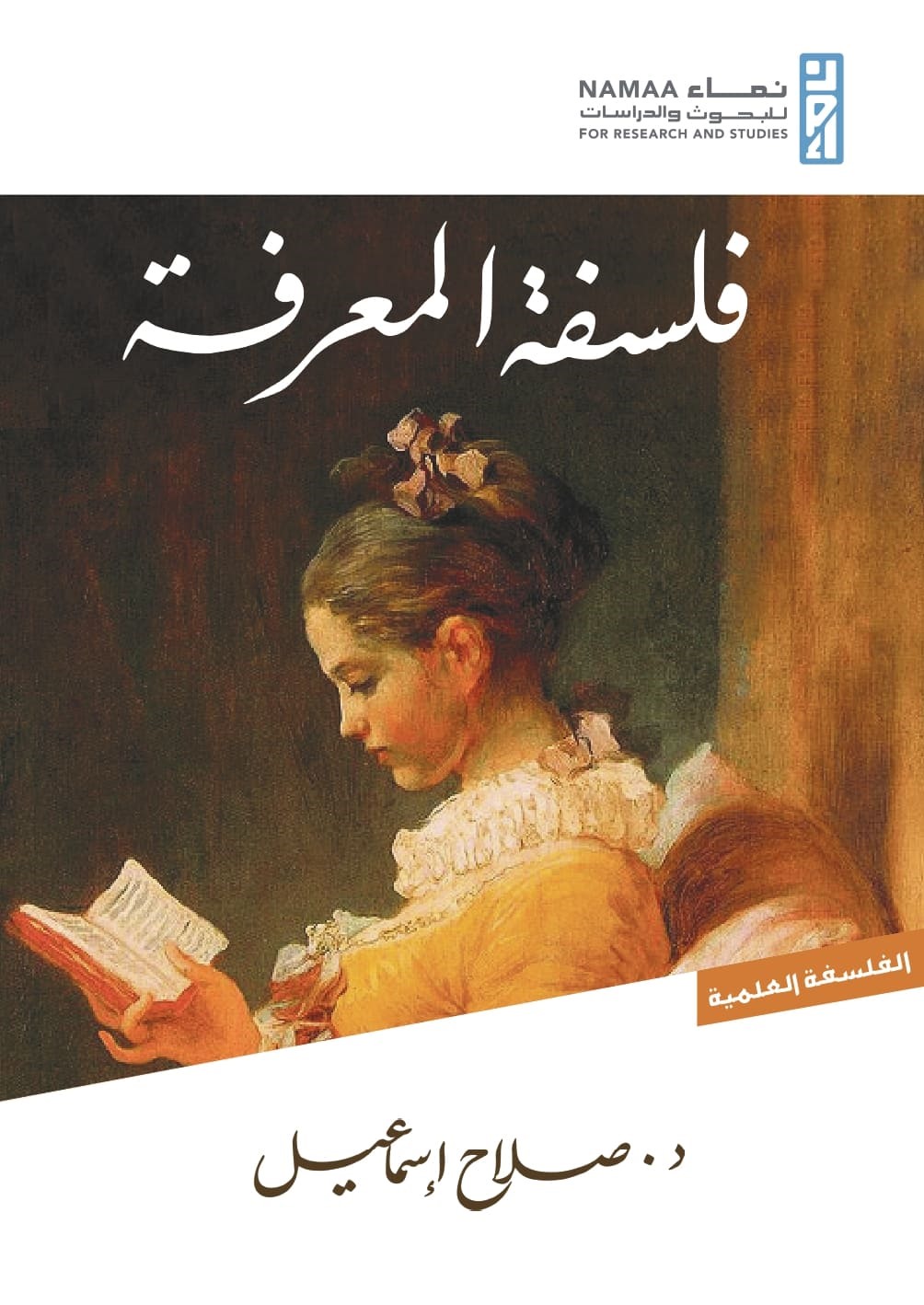مقالات
التفاصيل
الرغوة
الرغوة
أحمد سالم
﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما يَنفَعُ النّاسَ فَيَمكُثُ فِي الأَرضِ ﴾ [الرعد :١٧].
(1)
في ثلاثينيَّاتِ
القرن العشرين وُلدت العلامة التجارية الخاصة بمعجون الأسنان بيسودنت، وبالتعاون
مع عملاقٍ من عمالقة فن الإعلان والترويج في هذا الوقت (كلود سي. هوبكنز) تم بيعُ
الملايين من هذا النوع؛ ليتحولَ معجون الأسنان من يومها وحتى وقتنا هذا إلى سلعة
من أكثر السلع رواجًا، وليتحول استعماله إلى عادة من العادات اليومية في العالم
أجمع.
قبل هذا التاريخ كان
معجونُ الأسنان موجودًا وبماركاتٍ مختلفة، ولكنه لم يكن أحد السلع الرائجة، ولم
يكن استعماله يُعد بمثابةِ عادة منتشرة، ولكن عبر تقنيات إعلانية لا زالت تُدرس
حتى اليوم؛ فَتح معجونُ الأسنان بيسودنت وحملتُه الإعلانية البابَ للتحول الكبير
الذي طرأ على هذه السلعة.
أحد التقنيات المهمة
التي ساهمت في هذا كانت أن مُبتكِرَ هذه الماركة الجديدة من معجون الأسنان قد أضاف
لتركيبته حامض السيتريك، وجرعاتٍ من زيت النعناع مع مكونات كيميائية أخرى ساهمت في
إعطاء هذا المعجون إحساسَ الوخز اللاذع والمنعش الذي تشعر به عند استخدام معجون
الأسنان، وقد استمر استعمال هذه التقنية التاركة لهذا الأثر في مختلف أنواع
المعجون من يومها حتى وقتنا هذا.
تقول تريسي
سينكلير مديرة ((ORAL P)) ومعجون كريست:
(إن العملاء يحتاجون إلى إشارةٍ من نوعٍ ما إلى أن المنتجَ يعمل بنجاح، ونحن
نستطيع أن نجعل نكهة معجون الأسنان بأيِّ صورةٍ طالما يشعر الناس بالوخز المنعش،
فإنهم يشعرون بأن أفواههم تبدو نظيفة، إن هذا الوخزَ لا يجعل معجون الأسنان يعملُ
بشكلٍ أفضل، ولكنه يقنع الناس بأن المعجون
يعمل على أكمل وجه).
تُواصِلُ
سينكلير القولَ أيضًا بحسب ما ينقله عنها تشارلز دويج مؤلف كتاب قوة العادات: (إنَّ
تَكَوُّنَ الرغوة يمثل جائزةً كبيرة للغاية، إن الشامبو لا يتوجب عليه تكوين رغوة،
ولذلك فإننا نضيف موادَّ كيميائية مكونة للرغوة؛ لأن الناس يتوقعونها في كل مرة
يغسلون رؤوسهم، وينطبق الشيء نفسه على مواد تنظيف الملابس، ونحن نضيف مادة تُضيف
الرغوة لمعجون الأسنان، وليس لذلك فائدة صحية، ولكن الناس يشعرون بحالة جيدة عندما تكون هناك كمية من رغوة الصابون
حول أفواههم).
(2)
إن الأساس
الذي ترجع إليه تِقنِيَةُ الطعمِ اللاذع وتقنية الرغوة هو أساسٌ واحد، خلاصته:
افتقارُ الإنسان للشعور بالأثر السريع، افتقارُه لِرَدِّ فعلٍ ظاهر محسوس، حتى وإن
لم يكن كبيرَ الأثر، وحتى وإن لم يكن مفيدًا بالمرة.
لأجل ذلك:
فإن أكثر ما يُثنى به على المؤمنين هو أنهم يؤمنون بالغيب.
ولأجل ذلك
يُعد من معالم العبوديات العظمى:
استمرارُ الإنسان في الدعاء رَغم تأخرِ الإجابة، أو حتى رغم عدم الإجابة بالمرة.
فإن الإجابةَ السريعة
والنصرَ المعجل والإيمانَ المشهود= لا فضلَ لأحد فيها، فكل الناس بها يؤمنون، أما من يُغالِب طبعَ عجلة الإنسان لِشهود الأثر= فأولئك هم المؤمنون
حقًّا.
ولأجل ذلك:
يشعرُ الإنسان بالحاجة لكلماتِ الثناء على عمله، والمدحِ على فعله، وشَرَعَ الوحيُ
للناس أن يشكروا من أَحسَنَ إليهم؛ فلا يشكر اللهَ من لا يشكر النَّاسَ، ومن قال
لأخيه: جزاك اللهُ خيرًا فقد أبلغ في الثناء.
ولأجل ذلك:
تُعظِّمُ المرأةُ قدرَ الكلامِ الرومانسيّ، أو الهدايا اللَّطيفة، وتشكو زوجَها إن
افتقده، حتى وإن كان زوجًا محبًا صالحًا.
ولأجل ذلك:
يمكنك أن تكتفيَ في ردِّ السائلِ بالدعاء الحَسَنِ، ومَدَحَت العربُ –قديمًا- طِيبَ
القول في وجه السائل، ونهى القرآنُ عن نهرِ السائل، فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا
السّائِلَ فَلا تَنهَر﴾ [الضحى:١٠].
ويقول الشاعر:
لا خيلَ عندك تُعطيها ولا مال ... فليُسعِد النطقُ إن لم يُسعِد الحالُ
وإلى نفس الباب يَرجعُ
الأثرُ الإداريُّ لتحفيز الموظفين، والأثرُ التربويُّ للثَّناء على الأبناء إن
أحسنوا، ولنفس الباب يَرجع تَعلُّقُ قلوبِ الناس على مواقع التواصل بالإعجاب والريتويت،
بل لنفس الباب يرجع تَشوُّفُ الكُتَّابِ والباحثين لأن يَرَوا ذِكرًا لأعمالهم،
ولو بالانتقاد.
وتحت نفس
الأصل: يندرج خوفُ الناس من الفضيحةِ أمام
الناس، وهو خوفٌ يَغلُب في نفوسهم خوفَ العقابِ من اللهِ والفضيحةِ على رؤوس
الأشهاد يوم القيامة؛ لأن فضيحةَ الناسِ عقوبةٌ معجلة، وأثرٌ لاذعٌ قريب.
ولأجل ذلك
أيضًا: يَزهَد الناسُ في الأعمال الصغيرة
التي لا يُسمع بها، ويزهد الناس في الأعمال العظيمة لكنها طويلةُ المدى، لا يُرى
أثرها إلا بعدَ سنين قد تتخطى سنين عمرهم، ولأجل ذلك كله= أَكثَرَ الوحيُ من وعظ
نبيه بقَصص السابقين من أنبيائه: ألّا ينتظر ثمرةَ عمله، وأن يتجاوز الحاجةَ
الإنسانية لشهود الأثر؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأتي يومَ القيمة وليس معه
أحدٌ، وإنّ أكثر الأنبياءِ ماتوا ولم يَبلُغُوا مُرادَهم من أقوامهم.
(3)
لقد رأيت من ينافح عن
نزول اللهِ في ثلث الليل الآخر، يُثبِتُه صفةً للهِ في وجهِ مُنكِريه، ورأيتُه
أزهدَ الناسَ في الطاعةِ التي ليس نزولُ الله إلا مجردَ ترغيبٍ فيها وفي سلوكها؛
وما ذلك إلا لأن الجَدَلَ فِعلٌ مُعجَّلٌ يُلمَسُ أثره، والفعلُ مؤجَّلٌ ثقيلٌ تَطوِيه
جدران بيتك.
وفيما يسميه الناسُ
الهمَّ العامَّ، وخاصة عند وقوع المآسي الكبرى يفزعُ الناسُ إلى الكلام، ويُحبُّون
أن يَرَوا مَن حولهم مِن أهل الرأي والقلم يتكلمون؛ إن هذا الكلامَ يقوم مقام
الرغوة والأثرِ اللاذع، يُعطيك شعورًا بالعمل والإنجاز، ويجعلُك تُبَرِّدَ ما
يستعرُّ في نفسك من حرارةِ الأسى؛ لِتنقلب إلى سِربك آمنًا، قد اصطحبتَ معك شعورًا
زائفًا بأنك أدَّيتَ ما عليك.
أما مسالكُ العملِ
والتأثير الحقيقي، والتي قد يتصل بعضها بالفعل بما قمتَ بالثرثرة عنه= فإنك نادرًا
ما تطلُبها أو تسلكها، وقد رأيتُ
بعضَ مَن أعرفه ممن يَعُدُّ الكلامَ معيارًا لحَملِ هَمِّ المسلمين، لم يسلك أيَّ
مسلكٍ من مسالك النفع الذي يصل بالفعل للذين ظَّنَّ الكلامَ عنهم حملًا لهمومهم،
حتى الجودُ بالمال لم يسلك به طريقًا وهو مشرع بين يديه.
وتلك سُنَّةٌ سائرةٌ
في الناس؛ فالكلامُ خفيفٌ، والفعلُ ثقيل، والفراغُ يمتلئُ بالأسرع نفوذًا إليه،
ومشقةُ الكلام في حركةِ لسانٍ خفيف، ومشقةُ العمل حركةٌ بالبدن وبذلٌ بالمال،
وركوبٌ لمَشَاقٍّ تُخالِفُ أهواء النفوس، وقليلٌ من الناس يستطيعُ فعل ذلك، فيبقى
الكلام غنيمةً باردة تُقِيمُك مقامَ الباذل، وإنما أنت مُثرثر لا حظَّ لك في ميدان
البذل الحقيقي بنفسك أو بمالك.
وما أكثرَ ما رأيتُ
ممن يتكلمون عن همِّ الأمَّةِ، وطريقِ إصلاحها، وهم مِن أكسل الناس إذا قصدتهم
لعملٍ، ومِن أقعد الناسِ إذا أردتهم لصالحةٍ يقومون بها، أو ثغرٍ يقفون عليه.
وكل ذلك
فرعٌ عن هذا الأصل نفسه: أن الناسَ يُحبون أن
يَرَوا شيئًا مُعجلًا مَشهودًا، ولو كان قليلَ الفاعلية، ضعيفَ التأثير، ليس له
دورٌ حقيقيٌّ في مداواة ما يألمون منه.
الكلامُ
أثرٌ سريع، ورغوةٌ تُوهِمُك أنك أدَّيْتَ ما عليك، وتُوهِمُ من يَنظُرُ إليك أيضًا
أنك من أهلِ شُعَبِ الإيمان الذين يُؤَثِّرون في الحياة بما ينفعهم وينفع الناس،
والحالُ أنك مجردُ زَبَدٍ أَبيضَ، إذا زال رغاؤه لم يبقَ منه نفع.
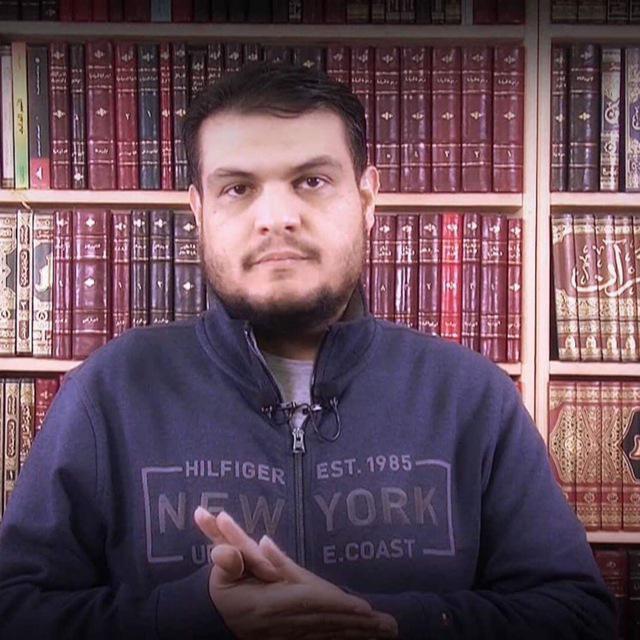
جديد المركز
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">لأن قضية التكفير طالتها بواعث المعاقبة والتشفي وعدم الانضباط المنهجي الشرعي، بالإضافة إلى غياب المحددات العقدية والقواعد الأصولية المحكمة الضابطة لمسار انتاج حكم شرعي بهذه الخطورة.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">ولأن الحكم على المعين المسلم من أهل القبلة بانتفاء الإيمان عنه وخروجه من دائرة الإسلام، وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية واعتقادية؛ تدخل انحرافاتها ضمن مساحات المخاطر التي تتهدد الاستقرار المجتمعي والأمن الفكري للشعوب المسلمة في أصقاع الأرض.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">سعى المؤلف، من خلال منهجية أصولية محكمة، لبيان القواعد الحاكمة لقضية تكفير أعيان المسلمين، وتحقيق أصولها وتجريد بُناها الشرعية مما علق بها من مسائل متشابكة ومتداخلة بفعل تعقيدات الواقع وقصور النظر المتفحص في القواعد الشرعية. كما بيّن المؤلف مناطات التكفير وأوجه المنع منه، من خلال مناقشة الوقائع والأحوال التي توجب التكفير وتضمر المنع منه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"Al Tarikh"; mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-bidi-language:AR-EG"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-ascii-font-family: "Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language:AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">عَرَف تاريخُ دراسة القرآن الكريم في الغرب تطورات جذرية من حقبة تاريخية إلى أخرى. ولم يحصل هذا التطور على مستوى فهم مضامينه وبحث قضاياه فحسب، بل على مستوى مناهجه واتجاهاته أيضًا. ولم تقع هذه التطورات -كما قد يعتقد البعض- بمعزل عن التطوراتِ الحاصلةِ في المجالات العلمية الأخرى، مثل الدراسات الكتابية أو العلوم الدقيقة أو الاجتماعية أو الإنسانيات، بل بلغ لظاها بشكل من الأشكال جوهرَ الدرس القرآني، وأثرت في تفسيره ومقاصده. غير أن حركة تطبيق مناهج هذه العلوم على نص القرآن دائمًا ما تتثاقل، وتتخلفُ عن ركب ووتيرة تطوراتها السريعة والمتنامية.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">وإذا كانت درجةُ الجدال والعلمية تتفاوت من مرحلة إلى أخرى، فلا يمكن الفصلُ بوضوح بين الدراسات «العلمية» و«الجدالية» إلا بتتبع تاريخ واتجاهات دراسة القرآن في الغرب. إذ تملك دراسة القرآن في الغرب تاريخًا قديمًا يعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. ومن ثم قد يسعف هذا التاريخ في تمييز الغث من السمين، وفهم نتائج الوضع الحالي وتفسيره، واستشراف مستقبل الدراسات المقبلة كذلك. ولا تنحصر فوائد هذا التحقيب في مساعدة القارئ على تسهيل المسار التاريخي للدرس القرآني في الغرب وإيضاحه فقط، بل يساعد على إلقاء الضوء على أسباب استمرارية بعض المواقف التاريخية أو تطور ظواهر واختفاء أخرى أيضًا. <o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">علاوة على ذلك، قد يساعد هذا التحقيب على نسج روابط سببية بين الفترات، والمقارنة بينها. ومع ذلك، لا بد أن نأخذ في الحسبان أن التحقيب في هذا السياق -بفعل معاييره النسبية- تحقيب وظيفي وغير قطائعي، نظرًا لتداخل الحقب، وامتداد مواضيع كل حقبة إلى الحقبة الموالية أو الأخيرة كذلك.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">لأن الإيمان بنبوة النبي ﷺ هو الشطر الثاني من شهادة الحق التي لا نجاة بغير الإيمان اليقيني بشطريها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسولُ الله. وهذا ما أوجب أن تكون دلائل نبوته ﷺ دلائلَ يقينيةً، لكي تُوصل إلى هذا اليقينِ الواجبِ والمشروطِ لصحة الإيمان.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">ولذلك فقد كتب أئمتُنا وعلماءُ أُمّتِنا كُتُـبًا كثيرةً وعَقَدُوا مباحثَ طويلةً في دلائل النبوة، وتنوعت طرائقُ تأليفهم في ذلك، وتعدّدت وجوهُ تناولهم له، واستطاعوا أن يقدموا الأدلة على صحة نبوة النبي ﷺ بأحسن طريقةٍ وأقومِ منهج. لكنهم كانوا يخاطبون أهل زمانهم بما لديهم من معارف، وبحسب ما تحتاجه أفهامُ المخاطَبين في عصرهم، وأجابوا عن كل إشكال كان يُطرح، وسَدُّوا كلَّ ثغرةٍ تُوُهِّمت في استدلالهم، ورَدُّوا كلَّ شُبهةٍ أثارها ذلك الاستدلالُ بلغةِ عصرِهم وحاجتِه، فجزاهم الله تعالى عن الإسلام وعلومه خير الجزاء.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">فلما أنْ بلَغْنَا نحن هذا العصر، وكان أكثر أبناء أُمتنا يجهلون تراث أُمّتهم، وبعض جهلهم به جهلُ معرفةٍ واطلاع، وبعضه جهلُ عجزٍ عن إدراكه وفهمه، بسبب ما حصل بيننا وبين تراثنا من قطيعةٍ تعبيرية واصطلاحية وأسلوبية، صار لا بُدّ من إعادة عرضٍ لبعض تلك الجهود في الدلائل النبوية، بطريقةٍ تقرّبها من عموم المسلمين، وتُيسِّرُ فهمها لهم، وتخاطبهم بلغة عصرهم وأساليبه، بل تحبِّبهم في معرفة ذلك، وتُشوِّقُهم إليه، وتُغريهم به؛ لأننا في زمن لا تحكم غالبَ الناس فيه إلا المتعةُ واللذة، فلا بد أن نحرص على تقريب علومنا إلى أبناء أمتنا بلغة يفهمونها، وبأسلوب يشوّقهم إلى معرفتها، بلا إخلالٍ بالحقيقة العلمية، ولا تسخيفٍ للمعارف الثقيلة.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-MA" style="font-size: 14pt; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">لقد ظل الدرس الفقهي حُرًّا، تسري الحياة في أوصاله ما بقي مستقلا عن السلطة السياسية، بل إنه ظهر ـ في بعض مراحل التاريخ الإسلامي ـ بوصفه قوةً شعبية تدفع جور السلطان، وتقف الناسَ على الحقيقة حين تسعى إلى طمسها حيلُ السياسة وأهواءُ الساسة. ولما آل أمره إلى الدولة ذهبت عنه ـ شيئًا فشيئًا ـ نضارة ذلك الوجه القشيب، واستحال التنوع المذهبي مع الأيام مذهبًا واحدًا، بل رأيًا واحدًا من الآراء التي ينطوي عليها ذلك المذهب، فلا يحل لمفتي الدولة الحيدةُ عنه في فتاواهم، ولا لقضاتها العدولُ عنه في أقضيتهم، واستوجب ذلك إنشاء نمط من التعليم الفقهي الموحد «المدعوم من السلطة السياسية» ليخرِّج المفتين والقضاة العالمين بهذا «المختار السلطاني»، العاملين به فيما يأتون وما يدعون، فتوحد النظام القضائي، غير أنه أثمر قضاة يعتقدون في أنفسهم أنهم «لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين»، وغلب على فقهاء ذلك العصر ـ في الجملة ـ إحساس «بالقصور» العلمي بالنظر إلى الفقهاء المتقدمين، فأورثهم ذلك عزوفًا «إراديًّا» أولَ الأمر، ثم «تلقائيًّا» بعد ذلك، عن الاجتهاد، ولو مذهبيًّا، ولا أدل على ذلك من المقارنة بين «القاضي» كما صوره الماوردي و«القاضي» في العصر العثماني، فإنها تُجمل ـ في رأيي ـ الاختلاف بين وضعين حضاريين، لا بين نظامين قضائيين فحسب.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">يقدم كتاب «إمبراطوريات الأفكار: إنشاء الجامعة الحديث من ألمانيا إلى أمريكا إلى الصين» وجبة تاريخية دسمة لكل باحث وأكاديمي مهتم بتاريخ وتطوّر نظام الجامعات الحديثة في كل من ألمانيا وأمريكا والصين، مستكشِفًا كيف أسهمت كل منطقة في تشكيل الهُوية التعليمية الحديثة في الداخل والخارج لهذه الجامعات، ثم تاريخ وتطوّر نظام الجامعات الحديثة في الصين، أبرز جامعات الصين، ويرجع تفرد المؤلف في سرد تاريخ الجامعات في الصين إلى كونه مؤرخًا للصين الحديثة.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">يُطالع القارئ في هذا الكتاب تاريخ نشأة وتطور وصعود أهم الجامعات الحديثة بداية من القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا في أوروبا وأمريكا؛ أما عن أوروبا، تحدث كيربي عن الجامعة الحديثة في ألمانيا، وقدم تغطية تاريخية وأكاديمية شاملة لنشأة الجامعة من خلال مقدمة تاريخية مفصلة، حيث يجد القارئ نفسه في جولة توصيفية لكل من جامعتي برلين الحديثة (جامعة هومبولت) وجامعة برلين العالمية الحرة.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">ثم ينتقل -على المنهجية نفسها- إلى أمريكا، ليقدم عرضًا ماتعًا لنشأة الجامعة الحديثة في الولايات الأمريكية، مع التركيز على أكبر الجامعات الخاصة والحكومية (هارفارد وكاليفورينا-بيركلي وديوك).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">ثم يعرض تاريخ وتطوّر نظام الجامعات الحديثة في الصين، وأبرز جامعات الصين، وهي: جامعة تسنغهوا، ثم نانجينغ وأخيرًا جامعة هونغ كونغ، ويرجع تفرد المؤلف في سرد تاريخ الجامعات في الصين إلى كونه مؤرخًا للصين الحديثة.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">ومن خلال تحليله للجامعات، يسلط كيربي الضوء على تفاعل الأفكار والأيديولوجيات والسياسات التعليمية التي أثرت على تكوّن ونمو هذه الجامعات محل البحث وكأنها دراسة حالة كما وصفها هو في مقدمة الكتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"Al Tarikh"; mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-ascii-font-family:"Al Tarikh"; mso-hansi-font-family:"Al Tarikh""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">كم من دراسة تناولت الحياة العلمية والثقافية والفكرية في الأندلس، هادفة لإبراز أهم المجالات العلمية وطرق التدريس والعلوم والمناهج الدراسية وكذلك المؤسسات والمعاهد التعليمية، فضلًا عن الدراسات الجمة التي أسهبت في حديثها عن الكتب والمكتبات الأندلسية، فشغلت حيزًا كبيرًا في الإنتاج العلمي خلال الفترات السابقة -رغم مجيء بعضها بشيء من العمومية في الطرح- كل هذا يؤكد على ثراء الحركة العلمية في الأندلس.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">وبما أنّ مهمة الباحث في التاريخ تناول الجزئيات والبحث فيها والتعمق في تفاصيلها محاولة منه كشف الصورة كاملة بقدر الإمكان، والتقاط الجزئيات والتفصيلات الصغيرة التي توطد لقيمة تلك المؤلفات السابقة وتدعم النظريات المتصلة بها.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">جاء من هنا موضوع هذه الدراسة عن <b>فقراء التعليم والعدالة الاجتماعية في الأندلس منذ عصر الخلافة حتى سقوط غرناطة (316هـ/929م-897هـ/1492م)؛</b> ليمثل حبة في عِقْد هذه الدراسات ويطرح تساؤلات جديدة عن</span><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">محاولة فهم التأثير السلبي للفقر على المجتمع، وتداعياته على التعليم كونه عاملًا أساسيًّا مؤديًا لارتفاع معدلات العزوف عنه.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">تدرس فلسفة العقل طبيعة العقل والحالات العقلية، وعلاقة العقل بالجسم. وتجيب عن أسئلة مثل: ما الوعي، وما القصدية؟ هل العقل الواعي فيزيائي أم غير فيزيائي؟ كيف يمكن لأفكارنا أن تمثِّل الأشياء في العالم؟ كيف ترتبط خبراتنا العقلية الذاتية -بما في ذلك أفكارنا وإحساساتنا وانفعالاتنا- بالحالات الفيزيائية لأجسامنا وأمخاخنا؟ كيف ينسجم الوعي مع العالم الفيزيائي؟ هل يستطيع العلم أن يكشف لغز الوعي؟ هل الحيوانات واعية؟ هل يمكن أن تكون الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر واعية؟ هل يمكن للتكنولوجيا المتقدمة أن تنقذ عقلك وتحوِّله إلى وسيط هندسي عن طريق تحميل عقلك على السحابة؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">يوضح هذا الكتاب كيف تحولت مثل هذه الأسئلة الفلسفية إلى أسئلة علمية يمكن حلها عن طريق إجراء التجارب، وبطريقة مدعومة بأجهزة متقدمة تتغلغل في عمق المخ. ويتجلى هذا في عمل مشترك بين الفلسفة وعلم المخ والأعصاب، وعلم النفس، وعلم الكمبيوتر، والعلوم الطبية أيضًا. استمتع بأدق دراسة منهجية وواضحة وشاملة عن العقل يقدِّمها لك رائد هذا المجال في الفكر العربي المعاصر.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"louts shamy";mso-hansi-font-family:"louts shamy"; mso-bidi-language:AR-EG">يمثِّل هذا الكتاب في تقديرنا واسطةَ العِقْد في الجهود العلمية الوافرة التي بذلها روزنتال، فلا جرم ظلَّ هذا الكتابُ مدةً طويلةً هو المرجع الأول لمن أراد الإلمام بالملامح الأساسية للفكر السياسي الإسلامي، والوقوف على عناصره المكوِّنة، ومعرفة ما طرأ على فنونه المختلفة من ألوان التطور. <o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"louts shamy";mso-hansi-font-family:"louts shamy"; mso-bidi-language:AR-EG">وعلى الرغم من تشكيك الدكتور حامد ربيع -رحمه الله- في صدق بواعث روزنتال واتهامه له بالتحيز إلى ديانته اليهودية، فلم يكن بوسعه إلا أن يُقِرَّ بالمكانة المرجعية الممتازة التي احتلها هذا الكتابُ؛ حيث قال قبل أربعة عقود: </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"louts shamy";mso-hansi-font-family:"louts shamy"">«إننا إذا أردنا أن نبحث عن عرض علمي للفكر السياسي الإسلامي في واقعه العربي، لما وجدنا سوى موقفٍ ندين به لعالم يهودي، أي «روزنتال». فقط في ذلك المؤلَّف نستطيع أن نجد عرضًا كاملًا بطريقة علمية تأبى إلا التحليل الوضعي المحايد ولو شكليًّا لمختلف عناصر الفكر السياسي الإسلامي».</span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">لأن الرازي يعد علمًا على مرحلة مهمة من مراحل تطور علم الكلام في الغرب الإسلامي، تسعى هذه الدراسة للتأريخ لظاهرة تفاعل المتكلمين المغاربة مع الإمام الرازي وطريقته الموسومة بطريقة المتأخرين. فكانت، من ثَمَّ، محاولة في كتابة تاريخ المذهب الأشعري في البلاد المغربية بعد تراكم الجهود المختلفة من الباحثين في هذا الباب، وتوالي ظهور نشرات أعمال المتكلمين المغاربة، وذلك بعد أن كانت حالتها المخطوطة تحد من الاستفادة منها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"Al Tarikh"; mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-bidi-language:AR-EG"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-ascii-font-family: "Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language:AR-EG"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">وتعد هذه الدراسة، أيضًا، إسهامًا في دراسة التاريخ الفكري المغربي، الذي يقوم جزء كبير منه، منذ الفتح الإسلامي، على تلقي المذاهب والطرائق والأعلام المشرقية. وقد كانت لتفاعل المغاربة مع المشارقة صور مختلفة، من قبيل العناية بتحصيل التواليف، وتدريسها، وشرحها أو اختصارها ونحو ذلك، مما نتج عنه نشاط الحركة العلمية في مختلف الفنون وتميزها باختيارات مغربية فريدة لا تخطئها أعين الباحثين</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:90%;font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-bidi-language:AR-EG"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">كما تخوض هذه الدراسة في رصد أثر فخر الدين الرازي على تطور علم الكلام أساسًا، حيث لا يخفى على المشتغلين إفادته من العلوم العقلية والمشاركة فيها، لا سيما في الحكمة والمنطق، بعد أن كانت هذه العلوم مرفوضة عند أغلب نُظَّار أهل السنة. فكانت هذه المصالحة سببًا في تجاوز بعض الإشكالات الكلامية في طريقة المتقدمين، وتقديم نماذج جديدة من المسائل والاستدلالات ميزت طريقة المتأخرين، وانتعشت معها العناية بتواليف الفلاسفة، لا سيما مصنفات الشيخ الرئيس ابن سينا. ومع تزايد الاهتمام في الدراسات المعاصرة بالرازي، بالعربية وغيرها، خصوصًا ضمن دراسة السينوية.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%; font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-bidi-language:AR-YE"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">كان للسيولة السياسية التي اتَّسم بها العالمُ الإسلاميُّ إبَّان العصر الوسيط أثرٌ بليغٌ على حركات الانتقال السكاني، سواءٌ أكانت هجرة دائمة أم ارتحالًا مؤقتًا؛ فلم تكن تُثير ما دأبت الدولةُ الحديثةُ على إثارته من النَّعَرات القومية، بل كانت «دارُ الإسلام» تهيِّئُ للمسلمين فُرَصَ الهجرة من بلد إلى آخر في حرية تامة؛ بوصفها وطنًا واحدًا متصلًا لا تقوم فيه الحواجزُ الجغرافية أو السياسية دون أفراد المسلمين، وإن تصادمت أهواءُ الحُكَّام وتباينت أغراضُ السياسة بمآربها ومنافعها.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%; font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-bidi-language:AR-EG"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">وكانت حركةُ الهجرة تتجه تلقائيًّا صوب مركز القيادة السياسية والحضارية الذي بدا من الطبيعي أن يتغيَّر من دولة إلى أخرى، وأن ينتقل من إقليم إلى آخر، على وفق تبدُّل الأوضاع وتغاير الظروف التاريخية؛ فكانت دمشقُ مركزًا لهذه القيادة تارة، وتمتعت به بغدادُ تارة أخرى، ثم انتقل إلى القاهرة/دمشق بقيام دولة المماليك منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) تارة ثالثة. وقد بدا هذا الانتقالُ الأخيرُ وثيقَ الصلة بنجاح دولة المماليك (648- 923هـ/1250- 1517م) في حماية الاستقلال السياسي للشرق الأدنى (مصر والشام والحجاز)، وعِصْمته من الوقوع في براثن الغزو المـُغُولي، وبما تهيَّأ لها من مقومات الجذب السكاني ما لم يتهيَّأ لغيرها من دول المشرق؛ فآثر الهجرةَ إليها كثيرٌ من المشارقة الذين تباينت أصولُهم الجغرافية وتنوعت انتماءاتُهم العِرْقية وتعددت فئاتُهم الاجتماعية، وتركوا في رحابها على تمادي الأجيال من الآثار السياسية والحضارية ما سجَّلته مصادرُ التاريخ تسجيلًا لا تعوزه كثرةُ الأدلة وقوةُ البراهين.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-bidi-language:AR-EG"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">لقد كانت دولةُ المماليك تمثِّل لثقافة المشرق الإسلامي أواخر العصر الوسيط سفينة النجاة، أو قُلْ «سفينة نوح»؛ إذ هيَّأت لهذه الثقافة ملاذًا آمنًا حافظ عليها وعصمها من الاندثار بعد أفول مراكزها الكبرى في العراق وإيران وبلاد ما وراء النهر.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">يثير هذا الكتاب إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بتقييم المجلات والمؤسسات والباحثين تقييمًا ببليومتريًّا من قِبَلِ قواعد البيانات الدولية الكبرى التي تتسم بالهيمنة، كما يثير إشكالية التحيزات الجيوسياسية والأيديولوجية الخفية التي تهيمن على عمليات التقييم، فضلًا عن رصده لعمليات إضفاء الطابع الإنجليزي على قواعد البيانات المصنفة، وفرض استعمال ببليوجرافيا إنجليزية تكون حصرًا -أحيانا- من المجلات الأمريكية الكبرى التي تتسم بطابع الهيمنة والاستحواذ أيضًا.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">أثارت الإشكالات وغيرها عند مؤلفي هذا الكتاب قلقًا وارتيابًا تولَّدَ عنهما شكٌّ ورفضٌ واستهجانٌ، وهؤلاء الباحثون هم علماء فرنسيون متخصصون في علم النفس، وتخصصُ علم النفس، في هذا السياق، يُعْتَبر نموذجًا للباحث الفرنسي في العلوم الإنسانية كلها، كما يعتبر -من وجهة نظري- نموذجا للباحث في العلوم الإنسانية في البلدان غير الناطقة بالإنجليزية.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-YE">إنه كتاب جريء جاد يحاور بمطرقة نيتشه التي تسعى بكل قوة إلى تحطيم أصنام الهيمنة الاستعمارية الكبرى، ويدعو إلى إعادة النظر في مسألة اللهاث خلف قواعد البيانات الدولية، ويعمل على تحطيم الصنم الأمريكي الببليومتري الذي لن يكون مهمًّا إلا لو تجاوز الغطرسة والهيمنة والتحيز والديكتاتورية في مجال القياس، والتعامل مع اللغات وبحوث الأمم الأخرى بعين متجردة من أي نزعة إقصائية.</span><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">فلسفة المعرفة من أكثر مجالات الفلسفة الخليقة بالمتابعة والنظر. فهي أشد هذه المجالات اتصالًا بالعقول، وتأثيرًا في القلوب والنفوس، وهي التي تزودنا بتوضيح مفهومي للمعرفة وعناصرها مثل الاعتقاد والصدق والتسويغ، وتوضيح معرفي للعلم ومفاهيمه مثل الوقائع والتجارب والفروض والنظريات. ومن دونها لا ندرك التمييز بين المعرفة والرأي والظن، ولا نجد طريقة منهجية لتمييز العلم من العلم الزائف. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">وتكسبنا فلسفة المعرفة فهمًا دقيقًا لفضائل العقل مثل الفطنة، والتعقل، والإخلاص، والتواضع العقلي، والانفتاح العقلي. وتنبهنا إلى رذائل العقل مثل الجهل، والتزمت الفكري، والتحيز، والتفكير بالتمني، والإهمال، والعُجْب.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">يقدم لك هذا الكتاب الاتجاهات الجديدة في فلسفة المعرفة مثل إبستمولوجيا الفضيلة، والإبستمولوجيا الاجتماعية، وإبستمولوجيا الجماعات، وتمييز العلم، والمعرفة العلمية والتكنولوجية. ويعالج المشكلات التي يصطرع حولها الفلاسفة الآن في هذا المجال معالجة أخص ما تمتاز به هو التعمق في الفهم والقصد والاعتدال في الحكم.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">لأن قضية التكفير طالتها بواعث المعاقبة والتشفي وعدم الانضباط المنهجي الشرعي، بالإضافة إلى غياب المحددات العقدية والقواعد الأصولية المحكمة الضابطة لمسار انتاج حكم شرعي بهذه الخطورة.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">ولأن الحكم على المعين المسلم من أهل القبلة بانتفاء الإيمان عنه وخروجه من دائرة الإسلام، وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية واعتقادية؛ تدخل انحرافاتها ضمن مساحات المخاطر التي تتهدد الاستقرار المجتمعي والأمن الفكري للشعوب المسلمة في أصقاع الأرض.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">سعى المؤلف، من خلال منهجية أصولية محكمة، لبيان القواعد الحاكمة لقضية تكفير أعيان المسلمين، وتحقيق أصولها وتجريد بُناها الشرعية مما علق بها من مسائل متشابكة ومتداخلة بفعل تعقيدات الواقع وقصور النظر المتفحص في القواعد الشرعية. كما بيّن المؤلف مناطات التكفير وأوجه المنع منه، من خلال مناقشة الوقائع والأحوال التي توجب التكفير وتضمر المنع منه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"Al Tarikh"; mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-bidi-language:AR-EG"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-ascii-font-family: "Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language:AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">عَرَف تاريخُ دراسة القرآن الكريم في الغرب تطورات جذرية من حقبة تاريخية إلى أخرى. ولم يحصل هذا التطور على مستوى فهم مضامينه وبحث قضاياه فحسب، بل على مستوى مناهجه واتجاهاته أيضًا. ولم تقع هذه التطورات -كما قد يعتقد البعض- بمعزل عن التطوراتِ الحاصلةِ في المجالات العلمية الأخرى، مثل الدراسات الكتابية أو العلوم الدقيقة أو الاجتماعية أو الإنسانيات، بل بلغ لظاها بشكل من الأشكال جوهرَ الدرس القرآني، وأثرت في تفسيره ومقاصده. غير أن حركة تطبيق مناهج هذه العلوم على نص القرآن دائمًا ما تتثاقل، وتتخلفُ عن ركب ووتيرة تطوراتها السريعة والمتنامية.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">وإذا كانت درجةُ الجدال والعلمية تتفاوت من مرحلة إلى أخرى، فلا يمكن الفصلُ بوضوح بين الدراسات «العلمية» و«الجدالية» إلا بتتبع تاريخ واتجاهات دراسة القرآن في الغرب. إذ تملك دراسة القرآن في الغرب تاريخًا قديمًا يعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. ومن ثم قد يسعف هذا التاريخ في تمييز الغث من السمين، وفهم نتائج الوضع الحالي وتفسيره، واستشراف مستقبل الدراسات المقبلة كذلك. ولا تنحصر فوائد هذا التحقيب في مساعدة القارئ على تسهيل المسار التاريخي للدرس القرآني في الغرب وإيضاحه فقط، بل يساعد على إلقاء الضوء على أسباب استمرارية بعض المواقف التاريخية أو تطور ظواهر واختفاء أخرى أيضًا. <o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">علاوة على ذلك، قد يساعد هذا التحقيب على نسج روابط سببية بين الفترات، والمقارنة بينها. ومع ذلك، لا بد أن نأخذ في الحسبان أن التحقيب في هذا السياق -بفعل معاييره النسبية- تحقيب وظيفي وغير قطائعي، نظرًا لتداخل الحقب، وامتداد مواضيع كل حقبة إلى الحقبة الموالية أو الأخيرة كذلك.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">لأن الإيمان بنبوة النبي ﷺ هو الشطر الثاني من شهادة الحق التي لا نجاة بغير الإيمان اليقيني بشطريها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسولُ الله. وهذا ما أوجب أن تكون دلائل نبوته ﷺ دلائلَ يقينيةً، لكي تُوصل إلى هذا اليقينِ الواجبِ والمشروطِ لصحة الإيمان.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">ولذلك فقد كتب أئمتُنا وعلماءُ أُمّتِنا كُتُـبًا كثيرةً وعَقَدُوا مباحثَ طويلةً في دلائل النبوة، وتنوعت طرائقُ تأليفهم في ذلك، وتعدّدت وجوهُ تناولهم له، واستطاعوا أن يقدموا الأدلة على صحة نبوة النبي ﷺ بأحسن طريقةٍ وأقومِ منهج. لكنهم كانوا يخاطبون أهل زمانهم بما لديهم من معارف، وبحسب ما تحتاجه أفهامُ المخاطَبين في عصرهم، وأجابوا عن كل إشكال كان يُطرح، وسَدُّوا كلَّ ثغرةٍ تُوُهِّمت في استدلالهم، ورَدُّوا كلَّ شُبهةٍ أثارها ذلك الاستدلالُ بلغةِ عصرِهم وحاجتِه، فجزاهم الله تعالى عن الإسلام وعلومه خير الجزاء.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:115%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">فلما أنْ بلَغْنَا نحن هذا العصر، وكان أكثر أبناء أُمتنا يجهلون تراث أُمّتهم، وبعض جهلهم به جهلُ معرفةٍ واطلاع، وبعضه جهلُ عجزٍ عن إدراكه وفهمه، بسبب ما حصل بيننا وبين تراثنا من قطيعةٍ تعبيرية واصطلاحية وأسلوبية، صار لا بُدّ من إعادة عرضٍ لبعض تلك الجهود في الدلائل النبوية، بطريقةٍ تقرّبها من عموم المسلمين، وتُيسِّرُ فهمها لهم، وتخاطبهم بلغة عصرهم وأساليبه، بل تحبِّبهم في معرفة ذلك، وتُشوِّقُهم إليه، وتُغريهم به؛ لأننا في زمن لا تحكم غالبَ الناس فيه إلا المتعةُ واللذة، فلا بد أن نحرص على تقريب علومنا إلى أبناء أمتنا بلغة يفهمونها، وبأسلوب يشوّقهم إلى معرفتها، بلا إخلالٍ بالحقيقة العلمية، ولا تسخيفٍ للمعارف الثقيلة.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-MA" style="font-size: 14pt; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">لقد ظل الدرس الفقهي حُرًّا، تسري الحياة في أوصاله ما بقي مستقلا عن السلطة السياسية، بل إنه ظهر ـ في بعض مراحل التاريخ الإسلامي ـ بوصفه قوةً شعبية تدفع جور السلطان، وتقف الناسَ على الحقيقة حين تسعى إلى طمسها حيلُ السياسة وأهواءُ الساسة. ولما آل أمره إلى الدولة ذهبت عنه ـ شيئًا فشيئًا ـ نضارة ذلك الوجه القشيب، واستحال التنوع المذهبي مع الأيام مذهبًا واحدًا، بل رأيًا واحدًا من الآراء التي ينطوي عليها ذلك المذهب، فلا يحل لمفتي الدولة الحيدةُ عنه في فتاواهم، ولا لقضاتها العدولُ عنه في أقضيتهم، واستوجب ذلك إنشاء نمط من التعليم الفقهي الموحد «المدعوم من السلطة السياسية» ليخرِّج المفتين والقضاة العالمين بهذا «المختار السلطاني»، العاملين به فيما يأتون وما يدعون، فتوحد النظام القضائي، غير أنه أثمر قضاة يعتقدون في أنفسهم أنهم «لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين»، وغلب على فقهاء ذلك العصر ـ في الجملة ـ إحساس «بالقصور» العلمي بالنظر إلى الفقهاء المتقدمين، فأورثهم ذلك عزوفًا «إراديًّا» أولَ الأمر، ثم «تلقائيًّا» بعد ذلك، عن الاجتهاد، ولو مذهبيًّا، ولا أدل على ذلك من المقارنة بين «القاضي» كما صوره الماوردي و«القاضي» في العصر العثماني، فإنها تُجمل ـ في رأيي ـ الاختلاف بين وضعين حضاريين، لا بين نظامين قضائيين فحسب.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">يقدم كتاب «إمبراطوريات الأفكار: إنشاء الجامعة الحديث من ألمانيا إلى أمريكا إلى الصين» وجبة تاريخية دسمة لكل باحث وأكاديمي مهتم بتاريخ وتطوّر نظام الجامعات الحديثة في كل من ألمانيا وأمريكا والصين، مستكشِفًا كيف أسهمت كل منطقة في تشكيل الهُوية التعليمية الحديثة في الداخل والخارج لهذه الجامعات، ثم تاريخ وتطوّر نظام الجامعات الحديثة في الصين، أبرز جامعات الصين، ويرجع تفرد المؤلف في سرد تاريخ الجامعات في الصين إلى كونه مؤرخًا للصين الحديثة.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">يُطالع القارئ في هذا الكتاب تاريخ نشأة وتطور وصعود أهم الجامعات الحديثة بداية من القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا في أوروبا وأمريكا؛ أما عن أوروبا، تحدث كيربي عن الجامعة الحديثة في ألمانيا، وقدم تغطية تاريخية وأكاديمية شاملة لنشأة الجامعة من خلال مقدمة تاريخية مفصلة، حيث يجد القارئ نفسه في جولة توصيفية لكل من جامعتي برلين الحديثة (جامعة هومبولت) وجامعة برلين العالمية الحرة.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">ثم ينتقل -على المنهجية نفسها- إلى أمريكا، ليقدم عرضًا ماتعًا لنشأة الجامعة الحديثة في الولايات الأمريكية، مع التركيز على أكبر الجامعات الخاصة والحكومية (هارفارد وكاليفورينا-بيركلي وديوك).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">ثم يعرض تاريخ وتطوّر نظام الجامعات الحديثة في الصين، وأبرز جامعات الصين، وهي: جامعة تسنغهوا، ثم نانجينغ وأخيرًا جامعة هونغ كونغ، ويرجع تفرد المؤلف في سرد تاريخ الجامعات في الصين إلى كونه مؤرخًا للصين الحديثة.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">ومن خلال تحليله للجامعات، يسلط كيربي الضوء على تفاعل الأفكار والأيديولوجيات والسياسات التعليمية التي أثرت على تكوّن ونمو هذه الجامعات محل البحث وكأنها دراسة حالة كما وصفها هو في مقدمة الكتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"Al Tarikh"; mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-ascii-font-family:"Al Tarikh"; mso-hansi-font-family:"Al Tarikh""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">كم من دراسة تناولت الحياة العلمية والثقافية والفكرية في الأندلس، هادفة لإبراز أهم المجالات العلمية وطرق التدريس والعلوم والمناهج الدراسية وكذلك المؤسسات والمعاهد التعليمية، فضلًا عن الدراسات الجمة التي أسهبت في حديثها عن الكتب والمكتبات الأندلسية، فشغلت حيزًا كبيرًا في الإنتاج العلمي خلال الفترات السابقة -رغم مجيء بعضها بشيء من العمومية في الطرح- كل هذا يؤكد على ثراء الحركة العلمية في الأندلس.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">وبما أنّ مهمة الباحث في التاريخ تناول الجزئيات والبحث فيها والتعمق في تفاصيلها محاولة منه كشف الصورة كاملة بقدر الإمكان، والتقاط الجزئيات والتفصيلات الصغيرة التي توطد لقيمة تلك المؤلفات السابقة وتدعم النظريات المتصلة بها.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">جاء من هنا موضوع هذه الدراسة عن <b>فقراء التعليم والعدالة الاجتماعية في الأندلس منذ عصر الخلافة حتى سقوط غرناطة (316هـ/929م-897هـ/1492م)؛</b> ليمثل حبة في عِقْد هذه الدراسات ويطرح تساؤلات جديدة عن</span><span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh"">محاولة فهم التأثير السلبي للفقر على المجتمع، وتداعياته على التعليم كونه عاملًا أساسيًّا مؤديًا لارتفاع معدلات العزوف عنه.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">تدرس فلسفة العقل طبيعة العقل والحالات العقلية، وعلاقة العقل بالجسم. وتجيب عن أسئلة مثل: ما الوعي، وما القصدية؟ هل العقل الواعي فيزيائي أم غير فيزيائي؟ كيف يمكن لأفكارنا أن تمثِّل الأشياء في العالم؟ كيف ترتبط خبراتنا العقلية الذاتية -بما في ذلك أفكارنا وإحساساتنا وانفعالاتنا- بالحالات الفيزيائية لأجسامنا وأمخاخنا؟ كيف ينسجم الوعي مع العالم الفيزيائي؟ هل يستطيع العلم أن يكشف لغز الوعي؟ هل الحيوانات واعية؟ هل يمكن أن تكون الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر واعية؟ هل يمكن للتكنولوجيا المتقدمة أن تنقذ عقلك وتحوِّله إلى وسيط هندسي عن طريق تحميل عقلك على السحابة؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">يوضح هذا الكتاب كيف تحولت مثل هذه الأسئلة الفلسفية إلى أسئلة علمية يمكن حلها عن طريق إجراء التجارب، وبطريقة مدعومة بأجهزة متقدمة تتغلغل في عمق المخ. ويتجلى هذا في عمل مشترك بين الفلسفة وعلم المخ والأعصاب، وعلم النفس، وعلم الكمبيوتر، والعلوم الطبية أيضًا. استمتع بأدق دراسة منهجية وواضحة وشاملة عن العقل يقدِّمها لك رائد هذا المجال في الفكر العربي المعاصر.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"louts shamy";mso-hansi-font-family:"louts shamy"; mso-bidi-language:AR-EG">يمثِّل هذا الكتاب في تقديرنا واسطةَ العِقْد في الجهود العلمية الوافرة التي بذلها روزنتال، فلا جرم ظلَّ هذا الكتابُ مدةً طويلةً هو المرجع الأول لمن أراد الإلمام بالملامح الأساسية للفكر السياسي الإسلامي، والوقوف على عناصره المكوِّنة، ومعرفة ما طرأ على فنونه المختلفة من ألوان التطور. <o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"louts shamy";mso-hansi-font-family:"louts shamy"; mso-bidi-language:AR-EG">وعلى الرغم من تشكيك الدكتور حامد ربيع -رحمه الله- في صدق بواعث روزنتال واتهامه له بالتحيز إلى ديانته اليهودية، فلم يكن بوسعه إلا أن يُقِرَّ بالمكانة المرجعية الممتازة التي احتلها هذا الكتابُ؛ حيث قال قبل أربعة عقود: </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"louts shamy";mso-hansi-font-family:"louts shamy"">«إننا إذا أردنا أن نبحث عن عرض علمي للفكر السياسي الإسلامي في واقعه العربي، لما وجدنا سوى موقفٍ ندين به لعالم يهودي، أي «روزنتال». فقط في ذلك المؤلَّف نستطيع أن نجد عرضًا كاملًا بطريقة علمية تأبى إلا التحليل الوضعي المحايد ولو شكليًّا لمختلف عناصر الفكر السياسي الإسلامي».</span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">لأن الرازي يعد علمًا على مرحلة مهمة من مراحل تطور علم الكلام في الغرب الإسلامي، تسعى هذه الدراسة للتأريخ لظاهرة تفاعل المتكلمين المغاربة مع الإمام الرازي وطريقته الموسومة بطريقة المتأخرين. فكانت، من ثَمَّ، محاولة في كتابة تاريخ المذهب الأشعري في البلاد المغربية بعد تراكم الجهود المختلفة من الباحثين في هذا الباب، وتوالي ظهور نشرات أعمال المتكلمين المغاربة، وذلك بعد أن كانت حالتها المخطوطة تحد من الاستفادة منها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"Al Tarikh"; mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-bidi-language:AR-EG"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-ascii-font-family: "Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language:AR-EG"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">وتعد هذه الدراسة، أيضًا، إسهامًا في دراسة التاريخ الفكري المغربي، الذي يقوم جزء كبير منه، منذ الفتح الإسلامي، على تلقي المذاهب والطرائق والأعلام المشرقية. وقد كانت لتفاعل المغاربة مع المشارقة صور مختلفة، من قبيل العناية بتحصيل التواليف، وتدريسها، وشرحها أو اختصارها ونحو ذلك، مما نتج عنه نشاط الحركة العلمية في مختلف الفنون وتميزها باختيارات مغربية فريدة لا تخطئها أعين الباحثين</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:90%;font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-bidi-language:AR-EG"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">كما تخوض هذه الدراسة في رصد أثر فخر الدين الرازي على تطور علم الكلام أساسًا، حيث لا يخفى على المشتغلين إفادته من العلوم العقلية والمشاركة فيها، لا سيما في الحكمة والمنطق، بعد أن كانت هذه العلوم مرفوضة عند أغلب نُظَّار أهل السنة. فكانت هذه المصالحة سببًا في تجاوز بعض الإشكالات الكلامية في طريقة المتقدمين، وتقديم نماذج جديدة من المسائل والاستدلالات ميزت طريقة المتأخرين، وانتعشت معها العناية بتواليف الفلاسفة، لا سيما مصنفات الشيخ الرئيس ابن سينا. ومع تزايد الاهتمام في الدراسات المعاصرة بالرازي، بالعربية وغيرها، خصوصًا ضمن دراسة السينوية.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%; font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-bidi-language:AR-YE"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">كان للسيولة السياسية التي اتَّسم بها العالمُ الإسلاميُّ إبَّان العصر الوسيط أثرٌ بليغٌ على حركات الانتقال السكاني، سواءٌ أكانت هجرة دائمة أم ارتحالًا مؤقتًا؛ فلم تكن تُثير ما دأبت الدولةُ الحديثةُ على إثارته من النَّعَرات القومية، بل كانت «دارُ الإسلام» تهيِّئُ للمسلمين فُرَصَ الهجرة من بلد إلى آخر في حرية تامة؛ بوصفها وطنًا واحدًا متصلًا لا تقوم فيه الحواجزُ الجغرافية أو السياسية دون أفراد المسلمين، وإن تصادمت أهواءُ الحُكَّام وتباينت أغراضُ السياسة بمآربها ومنافعها.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%; font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-bidi-language:AR-EG"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">وكانت حركةُ الهجرة تتجه تلقائيًّا صوب مركز القيادة السياسية والحضارية الذي بدا من الطبيعي أن يتغيَّر من دولة إلى أخرى، وأن ينتقل من إقليم إلى آخر، على وفق تبدُّل الأوضاع وتغاير الظروف التاريخية؛ فكانت دمشقُ مركزًا لهذه القيادة تارة، وتمتعت به بغدادُ تارة أخرى، ثم انتقل إلى القاهرة/دمشق بقيام دولة المماليك منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) تارة ثالثة. وقد بدا هذا الانتقالُ الأخيرُ وثيقَ الصلة بنجاح دولة المماليك (648- 923هـ/1250- 1517م) في حماية الاستقلال السياسي للشرق الأدنى (مصر والشام والحجاز)، وعِصْمته من الوقوع في براثن الغزو المـُغُولي، وبما تهيَّأ لها من مقومات الجذب السكاني ما لم يتهيَّأ لغيرها من دول المشرق؛ فآثر الهجرةَ إليها كثيرٌ من المشارقة الذين تباينت أصولُهم الجغرافية وتنوعت انتماءاتُهم العِرْقية وتعددت فئاتُهم الاجتماعية، وتركوا في رحابها على تمادي الأجيال من الآثار السياسية والحضارية ما سجَّلته مصادرُ التاريخ تسجيلًا لا تعوزه كثرةُ الأدلة وقوةُ البراهين.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";mso-bidi-language:AR-EG"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">لقد كانت دولةُ المماليك تمثِّل لثقافة المشرق الإسلامي أواخر العصر الوسيط سفينة النجاة، أو قُلْ «سفينة نوح»؛ إذ هيَّأت لهذه الثقافة ملاذًا آمنًا حافظ عليها وعصمها من الاندثار بعد أفول مراكزها الكبرى في العراق وإيران وبلاد ما وراء النهر.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">يثير هذا الكتاب إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بتقييم المجلات والمؤسسات والباحثين تقييمًا ببليومتريًّا من قِبَلِ قواعد البيانات الدولية الكبرى التي تتسم بالهيمنة، كما يثير إشكالية التحيزات الجيوسياسية والأيديولوجية الخفية التي تهيمن على عمليات التقييم، فضلًا عن رصده لعمليات إضفاء الطابع الإنجليزي على قواعد البيانات المصنفة، وفرض استعمال ببليوجرافيا إنجليزية تكون حصرًا -أحيانا- من المجلات الأمريكية الكبرى التي تتسم بطابع الهيمنة والاستحواذ أيضًا.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG">أثارت الإشكالات وغيرها عند مؤلفي هذا الكتاب قلقًا وارتيابًا تولَّدَ عنهما شكٌّ ورفضٌ واستهجانٌ، وهؤلاء الباحثون هم علماء فرنسيون متخصصون في علم النفس، وتخصصُ علم النفس، في هذا السياق، يُعْتَبر نموذجًا للباحث الفرنسي في العلوم الإنسانية كلها، كما يعتبر -من وجهة نظري- نموذجا للباحث في العلوم الإنسانية في البلدان غير الناطقة بالإنجليزية.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-YE">إنه كتاب جريء جاد يحاور بمطرقة نيتشه التي تسعى بكل قوة إلى تحطيم أصنام الهيمنة الاستعمارية الكبرى، ويدعو إلى إعادة النظر في مسألة اللهاث خلف قواعد البيانات الدولية، ويعمل على تحطيم الصنم الأمريكي الببليومتري الذي لن يكون مهمًّا إلا لو تجاوز الغطرسة والهيمنة والتحيز والديكتاتورية في مجال القياس، والتعامل مع اللغات وبحوث الأمم الأخرى بعين متجردة من أي نزعة إقصائية.</span><span lang="AR-EG" style="font-size:14.0pt;line-height:90%;font-family:"KFGQPC Uthman Taha Naskh"; mso-ascii-font-family:"Al Tarikh";mso-hansi-font-family:"Al Tarikh";mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">فلسفة المعرفة من أكثر مجالات الفلسفة الخليقة بالمتابعة والنظر. فهي أشد هذه المجالات اتصالًا بالعقول، وتأثيرًا في القلوب والنفوس، وهي التي تزودنا بتوضيح مفهومي للمعرفة وعناصرها مثل الاعتقاد والصدق والتسويغ، وتوضيح معرفي للعلم ومفاهيمه مثل الوقائع والتجارب والفروض والنظريات. ومن دونها لا ندرك التمييز بين المعرفة والرأي والظن، ولا نجد طريقة منهجية لتمييز العلم من العلم الزائف. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">وتكسبنا فلسفة المعرفة فهمًا دقيقًا لفضائل العقل مثل الفطنة، والتعقل، والإخلاص، والتواضع العقلي، والانفتاح العقلي. وتنبهنا إلى رذائل العقل مثل الجهل، والتزمت الفكري، والتحيز، والتفكير بالتمني، والإهمال، والعُجْب.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "Al Tarikh";"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify; text-indent:36.0pt;line-height:90%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-YE" style="font-size: 14pt; line-height: 90%; font-family: "KFGQPC Uthman Taha Naskh";">يقدم لك هذا الكتاب الاتجاهات الجديدة في فلسفة المعرفة مثل إبستمولوجيا الفضيلة، والإبستمولوجيا الاجتماعية، وإبستمولوجيا الجماعات، وتمييز العلم، والمعرفة العلمية والتكنولوجية. ويعالج المشكلات التي يصطرع حولها الفلاسفة الآن في هذا المجال معالجة أخص ما تمتاز به هو التعمق في الفهم والقصد والاعتدال في الحكم.<o:p></o:p></span></p>