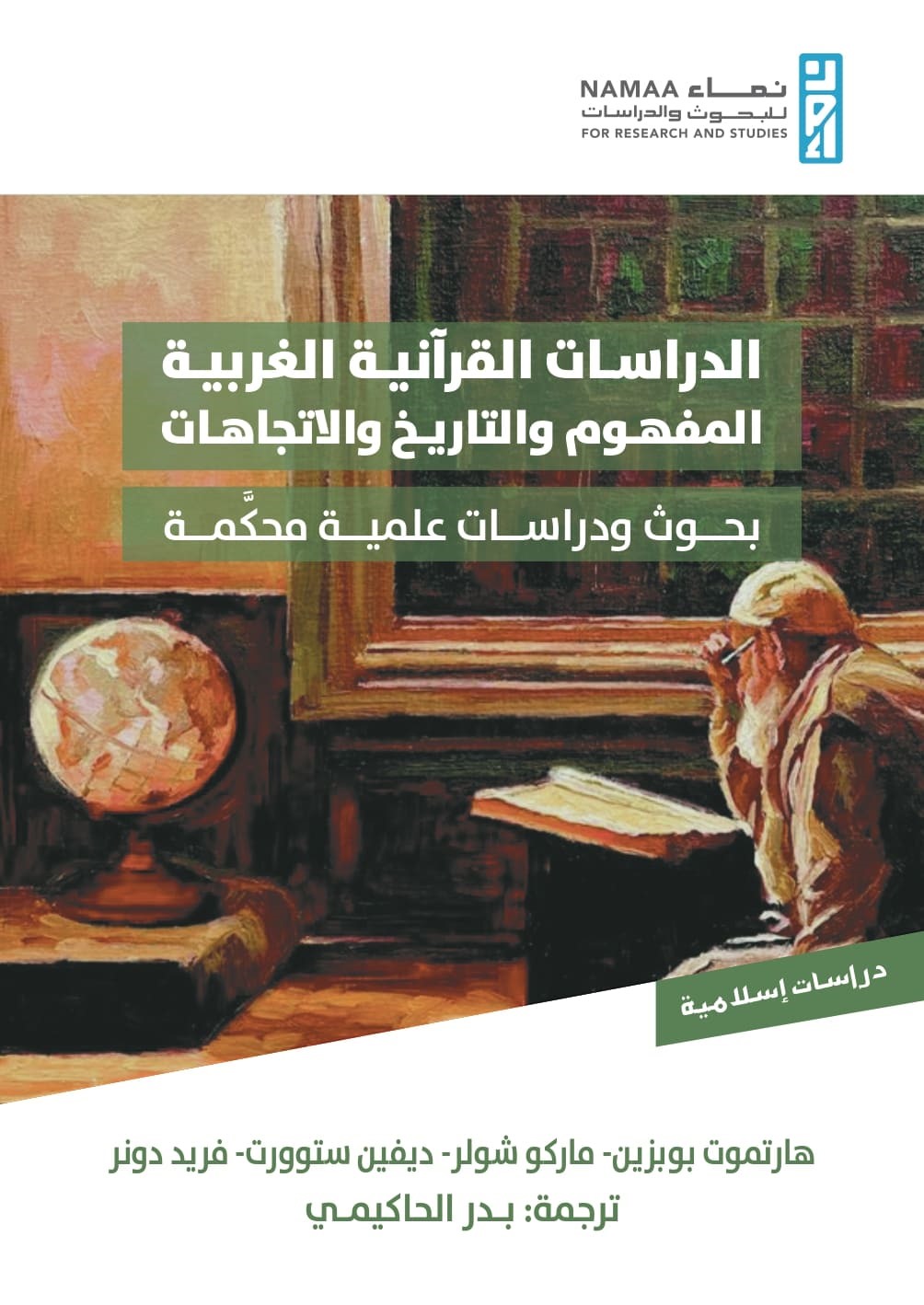الدراسات القرآنية الغربية: المفهوم والتاريخ والاتجاهات
«دراسات شرعية»
عَرَف
تاريخُ دراسة القرآن الكريم في الغرب تطورات جذرية من حقبة تاريخية إلى أخرى. ولم
يحصل هذا التطور على مستوى فهم مضامينه وبحث قضاياه فحسب، بل على مستوى مناهجه
واتجاهاته أيضًا. ولم تقع هذه التطورات -كما قد يعتقد البعض- بمعزل عن التطوراتِ
الحاصلةِ في المجالات العلمية الأخرى، مثل الدراسات الكتابية أو العلوم الدقيقة أو
الاجتماعية أو الإنسانيات، بل بلغ لظاها بشكل من الأشكال جوهرَ الدرس القرآني،
وأثرت في تفسيره ومقاصده. غير أن حركة تطبيق مناهج هذه العلوم على نص القرآن
دائمًا ما تتثاقل، وتتخلفُ عن ركب ووتيرة تطوراتها السريعة والمتنامية.
وإذا كانت
درجةُ الجدال والعلمية تتفاوت من مرحلة إلى أخرى، فلا يمكن الفصلُ بوضوح بين
الدراسات «العلمية» و«الجدالية» إلا بتتبع تاريخ واتجاهات دراسة القرآن في الغرب.
إذ تملك دراسة القرآن في الغرب تاريخًا قديمًا يعود إلى القرن الثاني عشر
الميلادي. ومن ثم قد يسعف هذا التاريخ في تمييز الغث من السمين، وفهم نتائج الوضع
الحالي وتفسيره، واستشراف مستقبل الدراسات المقبلة كذلك. ولا تنحصر فوائد هذا
التحقيب في مساعدة القارئ على تسهيل المسار التاريخي للدرس القرآني في الغرب
وإيضاحه فقط، بل يساعد على إلقاء الضوء على أسباب استمرارية بعض المواقف التاريخية
أو تطور ظواهر واختفاء أخرى أيضًا.
علاوة على
ذلك، قد يساعد هذا التحقيب على نسج روابط سببية بين الفترات، والمقارنة بينها. ومع
ذلك، لا بد أن نأخذ في الحسبان أن التحقيب في هذا السياق -بفعل معاييره النسبية-
تحقيب وظيفي وغير قطائعي، نظرًا لتداخل الحقب، وامتداد مواضيع كل حقبة إلى الحقبة
الموالية أو الأخيرة كذلك.